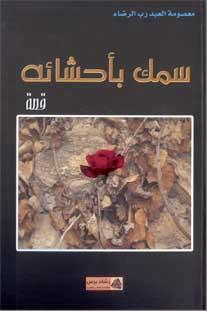سمك بأحشائه
لمعصومة العبد الرضا
إسُّ الحياة وعمادها تحقيق الذات المعرفية
وليس الغرف الحمراء
علي دهيني
بين صعب التحقق وبعيد المنال، هناك الممكن.. هذا ما خلصتُ إليه من خلال قراءتي لهذه الرواية القصيرة "سمك بأحشائه".
"ممكنٌ" لم تقدمه الكاتبة في روايتها على سبيل النصيحة، إنما على قاعدة الإنجاز الحقيقي.
وأصل الفكرة ليس أن نعتقد بالقدرة على التغيير، بل أن نعمل فعلاً عليه ونحققه.. بهذا يصبح الصعب وبعيد المنال، ممكناً.
تعرفت إلى الأستاذة معصومة العبد الرضاء، عبر الكلمة ـ وحقيقة لم يتسنّ لي معرفـتها عن قرب ـ من خلال كتابها الأول "وليف الحب في العلاقات الزوجية". هذا الكتاب في حينه لم يلق كبير اهتمام من النقاد، ربما لاعتباره كتاباً إرشادياً توجيهياً، بالرغم مما تضمنه ذلك الكتاب من نقاط أساسية مهمة في العقد الاجتماعي لجهة العلاقة بين أفراد المجتمع الصغير (الأسرة) ولم يطرح نظرية ثقافية جديدة يطلقها في مدار المجتمع الكبير الذي هو بيئة الكاتبة ومجتمعها، بل أعاد التذكير بالبديهيات المفترضة في الموضوع الذي تضمنته مادة الكتاب. وطبعاً لم ينل حقه من المراجعة المضمونية لمادته ومناقشتها، وكانت لي حينها وقفة مطولة مع ذلك الكتاب.
الآن بين يدي تجربة جديدة للاستاذة معصومة، تفتح عبرها خطاً آخر نحو محاكاة مجتمعها، تقدمه مثلاً استنهاضياً لتحريك السؤال الباعث على تنشيط وتحريك الذاكرة الموروثة لإخراجها من دائرة المتلقي الصامت إلى دائرة السؤال والبحث عن الأفضل في الذاكرة المكتسبة، دون أن تبادر إلى المواجهة والتحدي لِمَا تراه في هذا الموروث بحاجة الى التغيير أو التصويب في بيئتها ومجتمعها، بل من الإشارة إليه وتبيين الخطأ في ممارسته وليس في أصوله. وتنطلق في هذا من إيمانها بأن الفرد يمكن أن يكون خلاّقاً مبدعاً بذاته دون أن ينتظر من يدفعه أو يقدم له هذا التغيير ليتحول إلى مجرد مقلّد، أو يرسم له أسلوب حياته ليبقيه في الاسفل فيحرمه من الارتقاء بها إلى الأعلى ونحو الأفضل، وقد اعتمدت في هذا العمل الجديد لها، أسلوباً روائياً في تقديم المادة الفكرية وبلغة سهلة الاستيعاب غير معقدة الترميز أو الإشارات اللفظية فقط لكي تعبّر عن مقدرتها اللغوية أو الأكاديمية، لأن الهدف هو مخاطبة أكبر شريحة من المجتمع. أضف إلى ذلك أنها جعلت السياق العام للرواية وتقديمها على أنها سيرة فرد وليس حشود بشرية تتحرك بين السطور وعلى الصفحات. وهذا الاتجاه ظاهر منه أنها تريد أن تقول لكل قارىء، أن هذه الرواية يمكن أن تكون سيرة حياتك إذا ما اعتمدت ذات المنهج في أفكارك وتوجهاتك وطموحاتك التي لا يجب أن تتوقف عند نقطة واحدة في الحياة لأن الحياة استمرار، ولم تنس أن تبرز إمكانية الوصول للغايات السامية من خلال عصامية كاملة وانفتاح مدرك للمسؤوليات الإنسانية والاجتماعية.
من هنا نجد أنها اعتمدت أسلوب السيرة في السرد للتخلص، قدر الإمكان، من حشد الشخصيات وتكثيفها مما قد يشتت ذاكرة القارىء في البحث عن أي شخصية يختارها في الرواية لتمثله، لأن الهدف هو الموضوع والغاية هي التحفيز. وهذا ما نلمسه من خلال مواجهتها المباشرة مع الحالة الفكرية أو الايديولوجية العقائدية حين تنتقد الكثير من المصطلحات الموروثة من خلال العادات والتقاليد والتي لا علاقة لها بحقيقة الأصول الفكرية والايديولوجية لهذه البيئة وهذا المجتمع.
وبكل تأكيد فإن محاكاة الواقع الفكري لا تخلو من الخطورة، لما تفرضه هذه المحاكاة من التعاطي مع السمات الايديولوجية لأي مجتمع يمكن أن يشكّل مسرحاً لحركة روائية، والاستغراق في دائرة الأيديولجيات، ليس من السهل التعاطي معه، بل، أو مجرد القبول به كعمل أدبي هادف أو كنقد اجتماعي يرجى منه أخذ العبرة، لأنه سيصنف بالبديهة على أنه تشريح أو تفعيل لدور هذه الفكرة أو تلك.
وإذا كانت بعض الروايات العالمية التي مثل الأم والبوؤساء أو غيرها، تضمنت وجهاً ايديولوجياً فقد حاكته من الوجهة الإنسانية، ولم تعرضه كنظام حياة أو عقيدة مجتمع.
كذلك نجد الكاتبة العبد الرضاء، تدخل في نقاش ثقافي حاد مع ثقافات أخرى من خلال المفاهيم البديهية، وتجعله نقاشاً عادياً يمكن أن ينطق به أي لسان بعيداً عن الغوص في المبادىء والجذور الثقافية عند الآخر، لأن المهم في أي حوار ليس تسجيل النظريات وتكديسها في أروقة الجامعات وأرفف المكتبات، بل المهم هو ما يندرج على ألسنة الناس، والذي هو في حقيقته نتجية تلك النظريات الجدلية والفلسفية التي أنتجت ذهنيات ذات رؤيا معينة وأنتجت مواقف تتناقض والأهداف السامية لحقوق الإنسان، وهذا ما نقرأه من حواراتها في أروقة إحدى الجامعات الأميركية، حيث تسجل جرأة قوية في تقديم مبادىء ثقافتها القائمة على اعتبار أن الانسان قيمة بذاته البشرية ولا يجوز التمييز بين إنسان وآخر بذهنية الدونية، فتعبّر عن ارتباطها بجذورها الثقافية وفي انتمائها القومي الذي تفخر به برغم رؤية الآخرين له من منظار مختلف.
الرواية القصيرة والقصة الطويلة
إن الرواية في هذه الحقبة الزمنية وفي سياق تطور الفكر الحداثي، وصلت إلى مرحلة من النسيان المتعمّد، ربما، أو غير المقصود نتيجة تسيُّد القصة القصيرة المضغوطة الأحداث والتفاعلات، فيما كانت منذ أوائل الأربعينات من القرن الماضي وإلى أواخر الثمانينيات، هي أداة الإبداع السردي إلى جانب المنبر الشعري الذي أكثر ما ازدهر في فترة السبعينيات. وكذلك لحق به النقد الأدبي في تقييمه ودراسته للاعمال الأدبية.
وبرغم إن الرواية التي بين أيدينا لم تبالغ في التطويل وحاولت أن توائم بين الرواية القصيرة أو القصة الطويلة، فهي لم تستند إلى مرجعيات تخيُّليَّة غير واقعية أو استحضرت الخيال لتشكيل مبانيها الروائية، بل انطلقت من خلال قراءتها لما حولها، فلم تتقمّص أو تحوّل، ما يحيط بها، إلى أجساد وأفعال عدة تحركها على صفحات روايتها، لتنال رضى الباحثين عن الجمالية الفنية في الجمل المضغوطة والمنثورة بغير الواقع. ولذا اعتمدت الزمان والمكانن الواقعيين بما فيمها من الإشكالات، وما يحتاجانه من معالجة مباشرة. وابتعدت عن التورية أو الترميز، بل جاءت مباشرة لتعرض المشكلة بكل ما تحمله من أمل وألم في ذات الوقت، برغم السرد الإيجابي من حيث الشكل.
وإذا كان المطلوب في الرواية تسجيل رؤية الكاتب وقراءته لواقع أو حالة أو مرحلة، نجد أن الكاتبة هنا لجأت إلى إخراج الرؤيا وإظهارها من قلب الواقع، لتضيء على ما يحمله في داخله من موروث لا بدّ أن يتم العمل على تطوير الجيد منه وتنقيته مما يسيء لحالة التطور ومحاكاة العصر الحاضر، وانطلقت في نقل الأحداث من خلال ردود بطلة الرواية وأفعالها وأفكارها. بينما في الرواية العادية، غالبا ما يلجأ الروائي إلى خلق عوالم من خارج الواقع ليهرب من الزمان والمكان فيوزعهما وينثرهما في محطات روايته، ليتمكن من محاكاة هذا الواقع، فيتحدى من خلال رؤيته ما يجده من إشكالات.
وعلى الرغم من أن الكثيرين يعتبرون أن الوصف في تشكيل الرواية يعتبر حشواً لا فائدة منه سوى التطويل، إلاّ أن الكاتبة هنا لم تتفاداه ولم تنغمس به كذلك، لأن من اعتبر أن الوصف هو كذلك، أراد أن يضمن سرعة في التبليغ وليس رغبة في غرس المفاهيم، ومن أهم العناصر الضرورية للرواية هي غرس المفاهيم. كما أبرزت الكاتبة، عنصراً مهماً وهو العمل على الصورة وتشكيلها، في ذات بطلة للرواية، وحركتها، والدخول في التفاصيل الدقيقة، في مشهدية ترتسم بعين الذاكرة وهي تلتقط الكلمات. ولم تستدع وجوهاً أخرى لتنطق على لسانها، بل تمكنت من تشكيل خلفيات الفكرة في ذات الشخصية وجعلتها المحور الذي يمكن أن ينقلنا في الزمان والمكان، وهذه براعة ذهنية تحسب للكاتبة، على الرغم من الاتجاه النقدي الحديث الذي يركز كثيراً على عناصر الإبداع المتخيّل ويعتبر أن المباشرة في أي عمل إبداعي لا تعطيه القيمة الفكرية والبعد الثقافي الطويل الأمد، بل إن المباشرة تجعله آنياً مرحلياً ولذا تنتفي منه صيغة الإبداع الخلاق. وهذه النظرية جاءت من خلال الحوارات النقدية بين القصة القصيرة والرواية الطويلة، برغم أن لكل من العملين خصائصه وعناصر تشكيله.
والآن تجري حوارات ونقاشات حول هذا الموضوع في أندية النقد الأدبي الغربية في سياق الحديث عن مرحلة ما بعد الحداثة، حيث وجدوا أنه لا بد من العودة للرواية لما تشكله من تأريخ حقيقي لثقافة أي مجتمع بخلاف القصة القصيرة التي تبقى عملاً مجزوءاً من أصل كلي. إن النقد الأدبي الذي ما زال ينمو في كل مرحلة كأنه على سباق مع الاطروحات الإبداعية المتشكلة بصيغ مختلفة والمتلونة بحسب مدارس مبدعيها، بدى مجزوءاً في معاينته لأي نص يتناوله أمام التفكيك الموضوعي والمفردة المضغوطة المتأثرة بما تتغذى به الذاكرة الزمنية في كل عصر أو في كل حقبة. بل وأكثر من ذلك، تحول النقد الأدبي إلى "نقد ثقافي" عام، لأن مجال النقد الثقافي يفسح في المجال للتعاطي مع أي موضوع، بشمولية أكبر وأوسع لتناقش ليس النص السردي أو الشعري أو اللوحة أو الذوق الفني في فن من الفنون، إنما لتوصّف الحالة الثقافية بعموم نتاجها. وهذا كله خاضع لحالة التشابك الإبداعي بين تشكيل اللوحة وسرد الرواية أو ضغطها لتصبح قصة قصيرة أعفت نفسها من ربقة السرد الذي يفرض تماسك الموضوع وإبقاء صيغة الترابط مرجعاً لا بد منه، وهذا يعني بالخلاصة التزام النص بالوجه الثقافي العام، وليس فقط بالسرد الأدبي الذي يمكن ان يقتصر أو أن يُعبّر عنه بقطعة أو عجالة صغيرة. وهنا نقف عند منبت القصة القصيرة.
فالقصة القصيرة يمكن أن تكون نصاً أدبياً سُبك بإضافة الشخصية للتعبير عن الموضوع، أو خاطرة وجدانية تشكلت في قلم الكاتب بلغة إنشائية أخذت من الشعر مفرداته وبعض جمله النثرية لتعبّر عن لحظة معينة أو مشهد إنساني أو صورة وجدانية، وأخذت من الرواية الانفعالية. وقد حمل الأدب القديم الكثير من القصص القصيرة، ولكنه لم يفصلها عن سياق النص الأدبي، لأنه لم يجد مبرراً لتفكيكها وتجزأتها، وهناك الكثير مما تحمله بطون الكتب الأدبية وأشهرها عند الجاحظ.
ولذا وجدنا أن إعطاء القصة القصيرة المكانة التي تبوأتها في الإبداعات الأدبية، كان من جهة استجابة لمفهوم العولمة وتعرضه للوجه الثقافي عند الشعوب، نتيجة عجزه عن مواجهة ثقافة متصلة الحلقات في أعمال أدبية متكاملة، وأن أفضل السبل هي التجزئة، وهي في خلفيتها كما استجابة للسوق، ولغة العرض والطلب، وكلها مصطلحات مادية تنتهي بالتعريفات المادية للإنسان ككل، عقلاً وروحاً وجسداً، وهي الفكرة التي دارت نقاشات كبيرة حولها بعدما ظهرت الديكارتية وبعدها النيتشية لتتحدثا عن ماهية الفكر ومصادره عند الإنسان، أهو ينتمي إلى عالم الماورائيات كما تحدث عنها ديكارت، وقبله المدرسة الارسطية، أم إلى عالم الماديات وأن الجسد هو الباعث على الفكرة كما حددها نيتشيه ومن نحو نحوه.
ومع اعترافنا بجودة وأهمية القصة القصيرة، لكننا لا نزال نعتبرها نتاجاً أدبياً مجزوءاً. ونجرؤ أن نقول أنها اقتبست من حيث الشكل، حين لجأ بعض القراء النقديين لاختصار أعمال أدبية كبيرة بنصوص مضغوطة لإيصال الفكرة كاملة عن محتوى الكتاب الذي بين أيديهم، ومن خلال تلخيص بعض الكتاب لرواياتهم أثناء الحديث هنها، فاستهوت هذه الطريقة نفوس بعض من يكنزون في ذاكرتهم أفكاراً متشابكة ومتشعبة ومتعددة الأوجه والموضوعات، أو الأفكار التعبيرية فحلوها كلوحة من قلم وحبر وورق بدل ان تكون ريشة ولون وقماش، فأخذوا بتفكيك هذه الأفكار وإفراد كل فكرة على حدة، فجاءت نصاً أدبياً مستقلاً وقطعة نثرية أو صورة تعبيرية مستقلة ساعدت على تذوقها لغة إنشائية بليغة في مفرداتها وتعبيراتها، وغالباً ما تلجأ القصة القصيرة في أعمالها الرمزية إلى العالم الافتراضي، وهو في اعتقادنا ما أنتج مفهوم القصة القصيرة استجابة لذهنية السوق في إطار استراتيجية العولمة الحديثة التي انطلقت من اعتبار ان العالم كله قرية صغيرة.
سمك بأحشائه
وبالعودة إلى الرواية التي بين أيدينا، يبقى أن هناك سؤالا إشكالياً، أو لنسمه إشكالياً بالرمز، وهو لماذا تفردت الكاتبة بإبراز العنصر النسائي في كل النقاط التي أثارتها، وتركت كل ذلك عهدة بيد المرأة، والمرأة وحدها، وغالباً ما جعلت الرجل مؤيداً لما تقوم به ولما ترغبه، مع تأكيدها على دور القيادة له وفقاً لطبيعة البيئة التي تنتمي إليها. حتى في حالة الصدام، حين تصطدم البطلة مع حماتها وتنتقدها، لتعود فيما بعد تقتبس منها!؟
وهل يمكن أن نعتبر ذلك بديهية غريزية، مثل لو أن الكاتب رجلاً لكان أتخذ الرجل بطلاً لروايته، وحمله كل هذه الاعباء. مع العلم أن كل الروايات التي كتبها رجال غالباً ما كانت المرأة العنصر الأبرز في الرواية.؟
هل يمكن اعتبار ذلك أنه رد على الرجل الذي اعتبر شخصه المبجّل وزعامته غير المنقوصة، في كل ما كتب.؟
الكل يعرف موقفنا من هذه النقطة وأننا نعتبر أن المرأة ند للرجل وهذا أمر محسوم. والأمر الآخر أننا لا نعترف بما يسمى بأدب نسائي وأدب رجالي.. وكأننا في بوتيك بيع الألبسة، بل هناك كلمة مطلوبة ورؤية مولودة في ذاكرة عقل منتج ومبدع، أما شكل الجسم ونوعه الذي يحمل هذا العقل، فله مكان آخر للتفصيل، وليس الكلمة والفكرة والإبداع الإنساني هو مجالها.
في بعض الإجابة على الأسئلة المفترضة، نجد أن الوجه الإنساني المتمثل بعلاقة العقل مع الحياة هو البطل الحقيقي في مجمل عناصر الرواية ومواقفها.. وبالتالي هو ما يشكل العرف العام في المجتمع البشري، لأن الروح الإنسانية من الناحية العاطفية، تمثلها المرأة من ضمن خصائص تمايزها وأدوارها في الحياة الأسرية، ولذا نجد في الرواية مشهداً إنسانياً مليئا بالشحن الإنساني في العلاقة مع الحياة التي أساسها الشريك، حين تعود إلى البيت ولاتجد هذا الشريك حاضراً فتلحق به الى المستشفى.
نقطة أخرى مهمة ربما جاء سرد هذه الرواية بها لتشكل رداً عفوياً على ما أنتشر في الأونة الأخيرة في معظم الروايات التي أطنب الحديث عنها، ونالت من القراءات والدعاية بكثير أكثر مما تستحق، وخاصة تلك التي جعلت المرأة جسداً للاستهلاك سلباً أو إيجاباً، ضحية أو مجرماً. وجعلت مسرح الحياة غرفة محتوياتها سرير وشمعة حمراء ورجل وإمرأة، بحيث لم تخلو رواية من غرفة حمراء وما يجري فيها من انفعالات شاء الكاتب أن يعبر عن القمع والبحث عن الحرية من خلال مشهدية رمزية واستعارة مجازية محفّزة كخطاب للوجدان الإنساني الذي يمثله المرأة والرجل. وأن العلاقة بين الرجل والمرأة هذا مآلها ومرمح تجوالها. في "سمك بأحشائه" للكاتبة معصومة العبد الرضاء، التي بين أيدينا الآن، ربما وجدنا جواباً على ما أريد أن يعبّر عنه على أنه إسُّ الحياة وعمادها حين تعتبر أن العزيمة في السعي الدؤوب نحو تحقيق الذات المعرفية هو الهدف الأسمى وهو الذي يجب أن نعقد العزم عليه، دون أن تهمل حميمية العلاقة بين الرجل والمرأة من خلال ما قدمته من مشاعر في مشهد البطلة حين وقفت على سرير زوجها في المستشفى تقبل قيح جراحه لتعطيه شعوراً بأهميته في حياتها وبقربها الوجداني منه.
وهذه نقطة جديرة بالوقوف عندها لتقول لنا الكاتبة بأن المرأة تمثل وجه الحياة.. سلباً وإيجاباً.
ومع أن في جعبتنا العديد من الأسئلة حول مضمون الرواية، لا نرغب في طرحها الآن، لكن يبقى سؤال لا بد من طرحه، ولا نعفي كاتبة "سمك بأحشائه" منه وهو لماذا أسندت البطولة للمرأة منفردة.؟
![]()
![]()
![]()