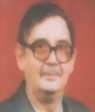خطوات في الليل ـ محمد الحسناوي
خطوات في الليل
رواية لمحمد الحسناوي

|
|
|
بقلم: عبد الله السلامة محمد الحسناوي
التواضع الجم، هو الذي أجاز، ابتداء، للأخ الحسناوي، أن يدفع بروايته هذه، إليّ لكتابة دراسة لها، فهل هذه الإشارة إلى تواضع المؤلف، تزكية مقصودة، جاءت في غير موضعها؟ لا. أهي جزء أساسي من الدراسة المتواضعة هذه؟ أجل.
ولم..؟
لأن التواضع جزء من شخصية المؤلف، ولأن شخصيته هي محور الرواية.. فالحديث عن عنصر من عناصر هذه الشخصية، أو جزء من أجزائها، أو صفة من صفاتها.. هو –حكماً- حديث عن عنصر من عناصر الرواية ذاتها، ونقصد هذه الرواية بالتحديد..
إن المؤلف هو بطل هذه الرواية.
قد يكون مكرهاً، في تمثيل دور البطولة على أرض الواقع، أو مكرهاً في صناعة بعض أحداثها على الأرض.. في دنيا الناس.. وقد يتمثل –لو أراد- بالمثل العربي القديم "مكره أخوك لا بطل" بل، لعله لم يغفل عن التذكير بهذا المعنى، في غير موقف من مواقف الرواية –الرواية المدونة على الورق، لا الرواية الحيّة على أرض الواقع- وحتى تلميحه، أو تصريحه، بأنه مكره عل تمثيل دور البطولة –في رواية الحياة- لا يخلو من تواضع.
فإذا كان مكرهاً هناك، في واقع الحياة، على تمثيل دور البطولة، أو تمثيل بعض أدوارها، كدور المنفي من بلاده، أو دور السجين مثلاً.. فهل هو مكره، حقيقة، على تمثيل هذا الدور –دور البطل- في الرواية المكتوبة..؟! لا نظن ذلك، بل نظنه اختار هذا الدور عن وعي وقصد وتصميم، وبإرادة حرة بعيدة عن كل ضغط أو إكراه، بعيدة عن فوهة المسدس، وجدران الزنزانة، وسجنته الجلاد..
وتتبلور عناصر المعادلة بالشكل التالي:
أ – بطل سياسي، يصنع أحداثاً في واقع الحياة، ويتخذ مواقف، ويخوض صراعات ويخضع لضغوط، ويتجرع مرارات.. وهو يفترض، أو يوحي، أحياناً، بأنه مكره على اختيار هذا الدور، ابتداء، ومكره على اختيار كثير من المواقف التي يقتضيها هذا الدور..
و "الإكراه على الاختيار" ليس فيه تناقض بين "مكره، ومختار" كما قد يتراءى.. فالحياة، بطبيعتها المعقدة، حافلة الاختيارات التي يكره عليها أصحابها إكراهاً.
نقول: قد يكون دور البطل السياسي –في الحياة- ملزماً باختيار مواقف معينة وانتقاء عناصر معينة، من عناصر الحركة الحية، على الأرض.. وقد لا تكون هذه العناصر الحركية المنتقاة، هي الأسلم، أو الأجود، أو الأكثر فنية، أو الأكثر انسجاماً مع السياق العام للدور البطولي بمجمله.. نقول: قد لا يكون ذلك كذلك، بالضرورة، في دور البطولة الحية المتحركة، فما الشأن، في دور البطل الفني.
ب – أيكون البطل "الفني" مكرهاً على الاختيار، اختيار المواقف والعلاقات وأنماط التفكير، وأساليب التخيّل والتصور واستعادة الذكريات، وممارسة الأحلام.. أحلام اليقظة وأحلام النوم؟
وإذا كان المؤلف "البطل السياسي" هو البطل "الفني" نفسه، فهل يجب عليه أن يطابق مطابقة تامة، بين جزيئات حياته التي عاشها على الأرض، وجزيئات حياته لتي يعيشها داخل روايته؟
أهو مكره فنياً على "اختيار" هذه المطابقة، بين سلوكه في "الرواية" وسلوكه في "الحياة" وبين بطولته "الواقعية" وبطولته "الفنية"؟ أهو مطالب "فنياً" أو "واقعياً" بترك هوامش، فسيحة أو ضيقة، بين عالم الواقع وعالم الرواية؟ أهو مطالب، بتجاهل أو بتناسي، كثير أو قليل من المفارقات والموافقات، بين دنيا الرواية "الفن" ودنيا الرواية "الحياة"؟ لابد من طرح هذه الأسئلة وغيرها، قبل الولوج إلى عالم الرواية.
لماذا؟
لأن عالم الرواية نفسه، عالم هذه الرواية، تحديداً، يطرح في داخله مثل هذه التساؤلات.
سيجد قارئ هذه الرواية، في الرواية، نمطاً من الكتابة يشبه نمط الكتابة التاريخية، من بعض الزوايا.. ويقترب من نمط كتابة المذكرات، من زوايا أخرى، ويتقاطع مع كتابة السيرة الذاتية، من وجوه، ومع كتابة قصص الرحلات، من وجوه أخرى.
سيجد القارئ، الحلم بأنواعه المعروفة والمتخيلة، كلها أو جلّها.
سيجد حلم اليقظة، وحلم النوم.. وحلم ما بينهما..
وسيجد حلم الرؤيا، وحلم الكابوس، وما بينهما من أضغاث أحلام.
وسيجد أنماطاً من الخيال: خيال الأديب، وخيال المفكر، وخيال السياسي، وخيال المسلم الداعية، وخيال السجين، "سجين الرأي" وخيال المنفي عن بلده، وخيال المحكوم بالإعدام، وخيال الإنسان، الذي خلف وراءه نصف قرن من الزمن، بما يحفل به من تجارب وذكريات.. وقبل هذا، وبعده وخلاله، خيال الأب والزوج، الذي ترك وراءه زوجاً وأبناء، لا يعرف في غيبته عنهم، ماذا فعلت بهم الأيام.
وسيجد القارئ، فوق هذا كله، نمطاً متميزاً من المغامرة.. المغامرة الفنية تحديداً.. نمطاً معروفاً، إلا أنه قد لا يكون مألوفاً، إلا للقليل من القراء.
إن الرواية، مغامرة حقيقية، في دائرة الفن الروائي، والعربي منه على وجه الخصوص –حسب رأينا واطلاعنا- وحين نقول مغامرة، فإنا نعي جيداً، الفرق بين المغامرة والمقامرة..!
فلم هي، في تقديرنا، مغامرة؟
هي مغامرة، لأنها جمعت عناصر شتى، في (توليفة) واحدة، ضمن إطار فني روائي واحد.
العناصر المذكورة آنفاً، مجموعة في إطار واحد.. ومعها: زمان هائل فسيح معلب في مجموعة محدودة من الأيام والليالي.. ومكان مترامي الحدود والأبعاد، مضغوط بين جدران زنزانة.. ومشاعر إنسانية شتى، لو حبست في مستودع صخري لحطمته وانطلقت.. محصورة في صدر رجل.. وأفكار فلسفية، وهموم اجتماعية، ومطامح سياسية.. محبوسة في رأس إنسان..
ثم: شعر وشعراء، ودعوة ودعاة، وسياط وجلادون، وأفراح وأتراح، وفراعنة ومستضعفون، وظلمات وأشعة.. مندغمة في تيار فني واحد، يعنف حيناً فيكون سهلاً، أو شلالاً، ويلطف حيناً، فيكون جدولاً أو ساقية.. يصطخب موجه كالبحر العاتي، أو ينساب رقراقاً كالنهر الصافي.
توليفة غير عادية، في إطار فني غير مألوف جداً.. بل غير مألوف.
ومن هنا، زعمنا أنها مغامرة.
فماذا نعني تحديداً؟
هل معنى ذلك، أن الرواية بدعة في عالم الرواية؟
أهي صيحة جديدة في دنيا الفن الروائي العربي؟!
الحق أننا لا نعني هذا.. ولا ذاك، على وجه التحديد.. ما نريد الوقوف عنده، هو الأسلوب، الأسلوب في تصور العناصر الفنية.. وفي حشدها، في صعيد فني واحد، وفي مزجها "فنياً" وفي رسم مسارات الحركة للشخوص مجتمعة، ولكل منها منفرداً.. وفي طريقة الحديث عن الأشخاص، وعن أفكارهم وتصوراتهم، ومواقفهم وعلاقاتهم، وفي إدخال الشعر، في نسيج الرواية، مشيراً أو محركاً، أو محرضاً، أو جالياً للهموم.. وفي تحديد نسبة "التوتر" أو "التوتير" الكامنة في النص أو المنبعثة عنه، من خلال تفاعل عناصره، وفي تحديد نسبة توزيع الأضواء الفنية، على كل عنصر، بحسب أهميته في الرواية.. وفي الإقدام على تمديد المشاعر حيناً، وعلى تكثيفها حيناً.. وفي التحكم بنسب درجات الحرارة، الممنوحة لكل نمط من أنماط الشوق: الشوق إلى الوطن، الشوق إلى الزوج، والولد، والشوق إلى إخوة الدرب، والأصدقاء، الشوق إلى مرابع الطفولة.. والصبا، وفي طريقة استعادة الذكريات.. واستعراضها وفي كيفية الإمساك بيد القارئ والسير معه في دروب الرواية، ليسمع.. ويرى.. ويتأمل.. وينفعل.. ويتعاطف.. ويحب.. ويكره.. ويضحك.. ويبكي..
قد يقال: وهل كاتب الرواية مكلف، بقياس هذه العناصر كلها.. أو حسابها بدقة!! وإذا كان مكلفاً بذلك، فبأي مقياس يقيس، أو بأي ميزان يزن..؟ بالميلليمتر؟ بالشبر؟ بالذراع؟ بميزان الذهب؟ بالقبّان الأرضي؟ بمقياس "ريختر" للهزات الأرضية؟ كيف تحسب النسب والمقادير في العمل الفني..؟!
وإذا كان لابد من حساب دقيق، لكل عنصر في الرواية، وكل نسبة، وكل مقدار.. فأي كاتب في العالم، يستطيع كتابة رواية مؤلفة من مئتي صفحة أو ثلاث مئة، أو أكثر، دون أن تنهار أعصابه، أو يتفجر دماغه، فينقل إلى مقبرة، أو مصح عقلي..؟!
وإذا لم يكن مكلفاً بحساب عناصره الفنية، بدقة متناهية، فهل هو معفى تماماً من حساب هذه العناصر..؟! أو متروك له الحبل على الغارب، يسرح كما يشاء، وأنى يشاء، بلا حسيب أو رقيب..؟!
الواقع أن الأمر لا هذا ولا ذاك.. بل هو بين بين.. أسلوب الصيدلي في حساب المواد الكيمياوية عند تركيب الدواء.. غير ممكن في العمل الأدبي عامة، والروائي خاصة، وترك الحبل على الغارب، غير مجد البتة، في أي عمل جاد.. فنياً كان أو غير فني.
فلابد إذن من درجة ما، لحساب العناصر الفنية.. ولابد من معيار ما، لتحديد صحة هذه الدرجة، وتحديد مدى الصدق، أو المعقولية، في عملية الحساب ذاتها..
هنا يدخل عمل المدارس النقدية.. بكل مذاهبها وأنماطها، وأدوات القياس الفني، المفضلة لدى كل منها..
وإذا كان الناقد لديه وسائله ومعاييره الفنية، التي يقيس بها صحة العمل الفني، أو جودته، فما حال القارئ العادي؟.. ما وسيلته، وما معياره؟ هنا، لابد من دخول الأهلية الخاصة لكل قارئ: الوعي، الثقافة، رهافة الحس.. المزاج، القابليات النفسية المتنوعة.
فهل الرواية، أية رواية، ملزمة بأن تقدم نفسها للقارئ، أي قارئ، بطريقة تناسب أهليته الخاصة؟.. وهل هناك رواية –أصلاً- قادرة على فعل هذا، إرضاء القراء، كل القراء.. على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم ومستوياتهم؟! إن في الأمر شكاً كبيراً.. فما المطلوب إذن؟ ما الذي يجب أن تقدمه الرواية للقارئ، لترضيه؟ القدرة على الشد، أو الجذب، أو التشويق أو الإثارة..؟ إن هذه لا تكفي وحدها وإلا لكانت الروايات البوليسية والروايات الجنسية الهابطة، هي وحدها الفن الروائي.. هي وحدها مجلى العبقريات الفنية في مجال الرواية.
فماذا إذن؟
المعاني الجليلة وحدها..؟ اللغة الراقية وحدها..؟ القدرة على رسم المواقف والشخصيات وحدها؟ القدرة على تحليل النفسيات، وتحديد مسارات الحركة..؟ القدرة على ضبط أنواع المشاعر، وأنواع الأفكار.. الملائمة بين كل شخصية وما يناسبها من حركة وذكر وإحساس ولغة..؟!
الحق أن الرواية، أية رواية، عالم مستكمل –أو هي كذلك بحسب الأصل- والإنسان، بطبعه، وبما أوتي من ملكات وطاقات، يملك خاصية التكيف مع العوالم التي يعيشها، أو يعيش فيها. قد يستطيع التكيف، بسهولة، أو بصعوبة، أو بمشقة، مع عالم ما.. وقد لا يستطيع التكيف البتة، مع أحد العوالم، لعدم ملاءمته لمزاجه، أو لتفكيره.. فإذا استطاع الانسحاب من هذا العالم.. انسحب.. وإذا كان العالم مفروضاً عليه.. بقي فيه على مضض، أو أبقي فيه وهو كاره.. فإذا قدمت الرواية، أية رواية، للقارئ، أي قارئ، عالماً يستطيع العيش فيه، والاستمرار في هذا العيش حتى النهاية.. عاش حتى النهاية.. نهاية العمل الفني..
وهذه –أي استطاعة العيش- درجة متدنية، من درجات التكيف مع العالم الفني.. وفوقها درجات:
الارتياح بدرجاته المختلفة
الاستمتاع بمستوياته المتعددة.
الرغبة في المزيد..
فلماذا؟ لماذا يفرض القارئ على الكاتب هذا الخيار الصعب: "يجب أن تقدم لي عالماً يعجبني.. وإلا انسحبت.."
لم يفترض القارئ أن الرواية هي عالم معدّ له، هو شخصياً، ليرتاح فيه ويستمتع، لم لا يفترض –أحياناً- أن الرواية، هي عالم خاص متميز للكاتب نفسه، عاشه هذا الكاتب في مرحلة ما، ثم قدمه للقارئ، ليتأمل في جوانبه، ويفكر، ويفيد منه حكمة، أو عبرة، أو أفقاً جديداً، أو معلومة نادرة، أو متعة –أحياناً- في بعض الزوايا، زوايا هذا العالم الفني المترامي، المتشعب، الخصيب، وإذا كانت الجسور بين الكاتب والقارئ، شتى متنوعة.. فلم يحرص القارئ مثلاً، على التعامل مع الكاتب، أو التواصل معه، عبر جسر واحد، هو الجسر الذي يحمل له –أي للقارئ- عنصر الامتاع الفني أو التشويق، وبخط ذي اتجاه واحد من الكاتب إلى القارئ، يمنع فيه المرور باتجاه معاكس؟
ولم تهمل الجسور الأخرى، ولم تهمل الخطوط الأخرى، التي هي معابر من جهة القارئ إلى جهة الكاتب، لمعرفة عالمه، بكل آفاقه وتشعبه، وبكل ما يحتويه من أفكار وأحلام ومواقف وعلاقات، ما دامت هذه كلها عناصر مشتركة –أو يمكن أن تكون مشتركة- بين الكاتب والقارئ.
وبطريقة معاكسة، نطرح السؤال التالي: أكل القراء هكذا؟ أكلهم يبحثون عن المتعة الفنية الخالصة، وفي أقصى درجاتها، التي يحملها عنصرا الجذب والتشويق.. ولا شيء يهمهم وراء ذلك.
والجواب ببساطة شديدة: لا..
فما المطلوب إذن؟
المطلوب هو أن نذكر أن هذه الأسئلة التي طرحناها آنفاً، ينبغي أن تطرح –حسب تقديرنا- بين يدي كل عمل روائي، بصرف النظر عن شخصية كاتبه وشخصية قارئه.
والمطلوب أيضاً، أن نعود إلى رواية الأستاذ الحسناوي لنلقي النظرات، هنا وهناك، على المناخات والبيئات والعوالم.. التي جمعها في مناخ واحد وبيئة واحدة وعالم واحد، ثم قدمها في إطار فني روائي واحد سماه "خطوات في الليل".
ونذكر في هذا الصدد بما يلي:
أ – مؤلف الرواية هو بطلها..
ب – فكرة الرواية: داعية مسلم مدرس مفكر أديب، تنشأ في بلده أحداث دامية بين السلطة الحاكمة، ومجموعة معارضة للنظام، فتلاحقه أجهزة أمن السلطة، فيتوارى، ثم يغادر بلاده ليستقر في بلد مجاور لها، ثم يعتقل في هذا البلد، ويحبس في زنزانة، لمدة ثلاثة أشهر تقريباً.. وفي الزنزانة تتجمع في ذهنه عناصر القصة وتتلاحم وتتفاعل مع جو الزنزانة، ليتشكل الإطار الفني العام، في عمومه، وفي كثير من خصوصياته.
ج – الإطار العام للتناول الفني الروائي (الشكل الخارجي) كتابة الرواية على شكل مذكرات، مؤرخة بأيام وليال: (النهار كذا).. (الليلة كذا).
د – زمان الأحداث:
هناك ثلاثة أزمنة، زمنان رئيسيان وآخر ثانوي: -الزمن الرئيسي الأول: هو الفترة التي قضاها المؤلف في السجن عام 1980، وهذا الزمن الرئيسي الضيق هو زمن تأريخ الأحداث.
- الزمن الرئيسي الثاني: هو حياة الكاتب برمتها، وهي في حدود نصف قرن تقريباً..
- الزمن الثانوي: هو زمن كتابة الرواية.. وقد جاء بعد خروج المؤلف من السجن، بحوالي خمس سنوات.
هـ - مناخ الرواية:
هناك ثلاثة مناخات للرواية كذلك:
- مناخ الزنزانة: بكل ما فيه من أحداث ومواقف وعلاقات ومشاعر وأفكار وضغوط وسجانين وأخيلة وأشواق.. وهو مناخ ضيق محدود بحدود الزنزانة، ثم حدود المبنى العام الذي يضم الزنزانة.
- مناخ الحياة: أي الحياة العامة الحرة الطليقة، التي كان الكاتب يحياها قبل دخوله السجن، بكل ما فيها من حرية وانطلاق، وضغط وملاحقة وأعداء، وأصدقاء، وزوج وولد وبيت، ومدارس وجامعات، وسياسة وأدب، وأحلام وذكريات.. وهذا هو المناخ الواسع العريض المترامي الحدود والأبعاد، في الزمان والمكان..
- مناخ التفاعل الأليم الطريف بين المناخين السابقين: وهو مناخ ذهني نفسي، عاشه الكاتب بالساعة واللحظة داخل زنزانته.. فصاغ منه عالماً فنياً زاخراً بالمفارقات والمتناقضات: حرية أسر.. وطن اغتراب.
و – سمات بارزة في الأسلوب:
- الجري وراء التداعيات الذهنية.
- إنطاق الآخرين بما لم يقولوا –مهما يقدر المؤلف أنهم يمكن أن يقولوه، على ضوء معرفته بنفسياتهم وظروفهم وأوضاعهم الاجتماعية.. وغيرها.
- استبطان نفسيات الآخرين، وإجراء حوارات داخلية في أعماقهم، وتصور أنهم يفكرون بكذا ويشعرون بكذا، على ضوء معرفة المؤلف بهم كذلك.
- المزج بين الحلم والواقع..
- نقل الكاميرا –كاميرا الخيال طبعاً- من مشهد إلى آخر، ومن زاوية إلى أخرى، خارج الزنزانة من ناحية.. وبين عالم الزنزانة والعالم الخارجي من ناحية أخرى، بأسلوب عمل، يشبه أسلوب عمل "كاميرات" الرحالة في بعض الأحيان..
- عدم الحرص على التقيد بالأساليب التقليدية المألوفة، لدى كتاب الرواية القدماء المعروفين، من إنجليز وفرنسيين وغيرهم –في مجال تحريك الشخصيات، وصناعة الحبكة الفنية، والمزج بلين عناصر العمل الفني، إذ اتخذ المؤلف هنا، نهجاً متميزاً، يقتضي التعامل معه بطريقة تناسبه، على ضوء اختيار المؤلف نفسه لمنهجه، لا على اختيارات الآخرين، ولا سيما أن الرواية "المثال" مفقودة، وأن الكاتب الروائي المثالي لم يولد بعد.
- إدخال الفن الشعري في نسيج الرواية، في مواضع عدة.
- الحرص على صناعة سلاسل معقدة من الحلم والواقع: واقع يولد أحلاماً تصنع واقعاً يحلم من خلاله الآخرون بواقع جديد، أو يحلمون كأنهم في واقع جديد..
- إدخال القرآن والتفسير والأقصوصة والمثل والطرفة.. في نسيج القصة الأصلية.
- استعراض فيلم سينمائي، مما اختزنته الذاكرة.
- أحاديث عن التذوق الفني والجمالي في بعض النصوص القرآنية والأدبية.
- حوارات مطولة حيناً، وموجزة حيناً.. حول قضايا سياسية واجتماعية..
- المزج بين أدق التفصيلات الواقعية، وبين أغرب السياحات الذهنية والخيالية، وقد تكون هذه السياحات باتجاه الماضي أو باتجاه المستقبل.
ز – خصوصيات:
في الرواية مجموعة من الخصوصيات،ـ يلحظها القارئ بنسب متفاوتة من التركز أو التركيز، في مواضع شتى من الرواية.
من هذه الخصوصيات ما يتعلق بالأحداث، ومنها ما يتعلق بالأفكار والمشاعر، ومنها ما يتعلق بطرائق التناول والعرض، ومنها ما يتعلق بالمرحلة التي عاشها الكاتب، ومنها ما يتعلق بشخص الكاتب نفسه.
وسنحاول تلمس بعض هذه الخصوصيات، وتسليط الضوء على بعضها..
1 – خصوصيات تتعلق بالأحداث:
من المعلوم أن لكل حدث خصوصياته التي تميزه عن الأحداث الأخرى، حتى تلك التي تشاركه في صفات وملامح كثيرة، ومن الأحداث ما يمكن تنميطه –إدراجه ضمن نمط معين- ومنها ما تصعب عملية تنميطه، إلى حد كبير أحياناً.
وأحداث الرواية هنا، في أساسياتها وفي الكثير من فرعياتها، تحمل خصوصيات متفاوتة في تفردها.
- ثورة إسلامية مسلحة ضد حكم كافر ظالم فاسد، يدعي الوطنية.. في سورية.. في عهد الطائفي حافظ أسد..
والخصوصيات هنا تكمن في المكان والزمان وطبيعة الثورة، وطبيعة الحكم.. فسورية –بصفتها مكاناً للأحداث- لم تعرف منذ فتحتها سيوف المسلمين، حكماً وطنياً، أو يدعي الوطنية، كافراً كفراً بواحاً، ويفرض على الناس القوانين الكافرة جهاراً نهاراً.. قبل هذه المرحلة التي تعيشها الآن.
وزمان الأحداث، هو العهد الذي تسلطت فيه الطائفية (...) بشكل سافر ورهيب على مقدرات البلاد ومصائر العباد..
والثورة هي ثورة إسلامية صرف، ليس لها أي رداء آخر من وطنية أو قومية أو نحو ذلك.
ونظام الحكم هو نظام متميز إلى أقصى حدود التميز، مميزاً في تاريخ سورية كله، ويختلف عن كل الثورات الأخرى التي قامت في العالم المعاصر..
يختلف عن ثورات الشيوعيين في آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا.. وفي أي مكان آخر في العالم..
ويختلف عن الثورات الوطنية ضد الاستعمار، التي قامت في العالم.. بما في ذلك الثورات السورية ويختلف غن الثورات التي قامت بها فئات إسلامية ضد حكومات وطنية مسلمة ظالمة، هذا على مستوى الحدث الرئيسي –المحور- في الرواية..
- أما الأحداث الفرعية المسببة للحدث الرئيسي، والمنبثقة عنه فكثيرة جداً ولكل منها طعمه وخصوصيته: المجابهات الدامية –الاعتقالات- المعاملة داخل السجون –التواري- مغادرة البلاد- سلوكيات النظام الحاكم وسلوكيات معارضيه، قيادات وأفراداً..
2 – خصوصيات تتعلق بالعمل الدعوي الإسلامي في سورية عامة، والإخوان منه خاصة:
لقد بسط المؤلف كثيراً من ممارسات الحركة الإسلامية في سورية، وعلى الأخص جماعة الإخوان المسلمين.. على مستوى التفكير والتحرك، وفي مستوى المطامح والأهداف، وعلى مستوى العمل السري والعلني، وعلى مستوى مشاعر القادة ومشاعر الجنود، وعلى مستوى العلاقات مع الدول والأحزاب..
وضمن خصوصيات العمل الإخواني نفسها، هناك خصوصيات مميزة لمواقف معينة، وعلاقات محددة، وأشخاص بأعيانهم..
3 – خصوصيات تتعلق بالمرحلة:
للمرحلة التي تفجرت فيها الأحداث الدامية في سورية، خصوصيات معينة منها:
- العلاقات بين نظام الحكم السوري والدول العربية المحاورة لها.
- الحياة السياسية والاجتماعية في سورية.
- علاقة النظام السوري بأحداث لبنان وعلاقته بالشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية.
- علاقة النظام السوري بالروس والأمريكان، وقضية أفغانستان..
4 – خصوصيات تتعلق بالمؤلف (بطل الرواية):
هناك خصوصيات للمؤلف (بطل الرواية) ذكرها بنفسه، وبشكل واع مقصود.. وهناك خصوصيات أخرى عرضها تفاعل الأحداث في الرواية بشكل غير مقصود. ومن أبرز خصوصيات المؤلف بشكل عام:
- طريقته في التفكير، وفي عرض القضايا الفكرية.
- طريقته في التواضع، وطريقته في فهم التواضع.
- أسلوبه في استدعاء النوم: عد الأغنام العائدة إلى الحظيرة.
- أسلوبه في استبطان نفسيات الآخرين، ونسج مشاعرهم الخاصة، وصياغة أفكارهم وتحريكها.
_ أسلوبه في التمويه على المحققين داخل السجن، وفي حجب المعلومات عنهم.
- أسلوبه في التعامل مع أهله: الزوج والولد والوالد والوالدة.
- طريقته في فتح بوابات الذكريات، وفي انتقاء الذكريات التي تعجبه والاسترسال في استعراضها.
- طريقته في ممارسة السياحة الذهنية والخيالية..
- طريقته في التعامل مع موجودات الزنزانة ومع شركائه فيها..
- طريقته في التعامل مع السجانين.. وفي تكوين الانطباعات عنهم..
- طريقته الذهنية في نسج الأحلام: أحلام اليقظة وأحلام النوم.
- طريقته في وصف ملامح إخوانه وأصدقائه، وفي التركيز على بعض الملامح والصفات.
- تصوره للعمل السياسي وضروراته ومسوغاته، وطريقته في عرض هذا التصور.
- أسلوبه في التعامل مع تفاعلاته الداخلية: الفكرية والشعورية، بشكل مقصود أو غير مقصود.
- طريقته في التعامل مع دواعي الشوق والحنين، بشكل واع أو غير واع.
- طريقته في استثارة الذكريات بشكل متعمد: للتسلية.
5 – خصوصيات تتعلق بطرائق التناول والعرض:
- إذا كان لابد من تصنيف الرواية ضمن مدرسة أدبية معينة، فيمكن القول إن هذه الرواية هي مدرسة نفسها، إذ ليس لها –بحسب اطلاعنا المحدود- مدرسة أدبية تنتمي إليها من الناحية الفنية.
- ثمة أسلوب مميز في مزج العناصر الفنية وأسلوب مميز في عرض هذا المزيج.
- مارس الكاتب طرائق خاصة به في المزج بين العناصر الفكرية والحسية، وبين الحركة والفكر.
- المراوحة والمزاوجة –بطرائق خاصة- بين أساليب عدة في النص.
الوصف: وصف ما تراه العين، وما تختزنه الذاكرة.
أفكار الآخرين.
الحوار: الداخلي – الخارجي: (بين شخصين حاضرين.. بين حاضر وغائبين) بين إنسان وطبيعة (من طرف واحد).
- استعمال تراكيب دارجة على ألسنة الناس أحياناً، أي من كلام الناس العادي، إلا أن ألفاظها فصيحة بشكل عام..
- السياحة الذهنية هي الطابع البارز الذي يندرج ضمنه كل أساليب القص (سرد –حوار- وصف- مونولوج- تخيل عوالم الآخرين الداخلية والخارجية) إلا أنها سياحة ذهنية خصبة منضبطة في حدود معينة، ومؤطرة بأطر معينة، وموجهة لخدمة الفكرة والفن معاً، ضمن منهج روائي مرن فضفاض، وفي أغلب الأحيان تكون السياحة الذهنية عملية واعية مقصودة. وقد يمارسها المؤلف في ظروف حصار ذهني شديد، حيث يستغرب أن ينطلق الذهن من إسار ظروفه الضاغطة، لينطلق في عوالم أخرى بحثاً عن ذكرى سارة، أو موقف بهيج، أو وجه حبيب غائب.
ح – وبعد!
قبل أن نختتم هذه الجولة القصيرة في رواية (خطوات في الليل) لا يسعنا إلا أن نشير إلى بعض الانطباعات التي خلفتها في الذهن والوجدان، فنقول:
1 – إن في هذه الرواية نوعين من المتعة:
النوع الأول والأهم: المتعة الكامنة في المعرفة ذاتها..
النوع الثاني: المتعة الفنية التي تغلف المعرفة أو تمازجها وتتفاوت حظوظ القراء من المتع.. كل بحسبه..
2 – إن هذه الرواية عالم رحب، فيه الغابة والبحر والجبل والصحراء، وفيه الشجرة والساقية، والصخرة والشلال.. فيه الذكرى البهيجة وفيه الألم المحض.. فيه الضحية البريئة، وفيه الوحش الكاسر، وفيه الظبي الشارد، وفيه طعوم الحياة جميعاً: الحلو.., الحامض.. المر..
وكما يتألم الإنسان ويفرح ويقلق وتتوتر أعصابه وتنفرج أساريره في الحياة.. كذلك قد يجد مثل هذا كله في الرواية.. وربما يجد المزيد.
3 – هذه الرواية ميدان خصب مثير، لتحليلات أنماط من المحترفين والهواة.. ولغير هؤلاء وأولئك من القراء.. وكل يخرج منها بقدر، ويظفر منها بطائل: الداعية المسلم.. رجل المخابرات... رجل القانون... الناقد الأدبي... رجل المبدأ أياً كان.. سجين الفكر... المشرد بسبب عقيدته... المضطهد في بلده فكرياً... المؤرخ.. المحلل النفسي..
كما يفيد منها بطرائق شتى، القارئ –أي قارئ- الذي لم يقيد مزاجه بنموذج معين من نماذج الراوية... القارئ الباحث عن المعرفة الممزوجة بمتعة فنية قصصية: معرفة ما جرى ويجري في سورية.. معرفة بعض مسارات الحركة والفكر لشرائح من الدعاة الإسلاميين، على مستوى الفرد والمجموعة.. معرفة ما يجري في الأقبية والسجون لرجال الفكر.. معرفة درجات التفاوت بين مواقف الدول تجاه حركة سياسية معينة، في ظروف معينة.. معرفة طعم الزنزانة وطعم الغربة، وطعم البعد عن الأهل والوطن.
ثم: معرفة أحلام الداعية المسلم: أحلام اليقظة وأحلام النوم.. ومعرفة أنماط من الصراعات والمفارقات والموافقات بين أنواع من الشرائح الاجتماعية والسياسية.
ومعرفة كيف يفكر ابن الخمسين، الإنسان، والرجل، والداعية، والمفكر، والأديب، والمنفي، والسجين، ثم: معرفة أسلوب جديد من أساليب الكتابة الروائية.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()