سراويل طنجة السردية

محمد غرافي
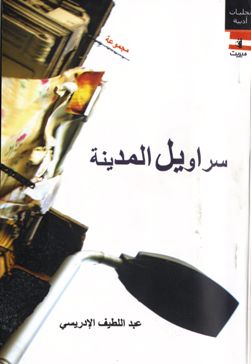
صدر عن دار ميريت للنشر نص سردي للقاص المغربي عبد اللطيف الإدريسي الذي أطلق عليه ـ تواضعا دون شك ـ صفة محكي. لكن سراويل المدينة[1] نص روائي بامتياز. فهو يرصد اليومي بكل جزئياته في شوارع وأزقة ومقاهي وحافلات مدينة عربية. بطل الرواية هو الأنا المتسكع الذي هَجر المدينة أو هُـجِّر منها وعاد إليها غريبا. كأنه جاء إليها من زمن آخر ضارب في القرون الغابرة. ولذلك جاء عنوان السروال الأول هكذا : "في تغريبة ابن بطوطة". لا يذكر السارد اسم المدينة مرة واحدة في الرواية، لكن كل الرموز والأسماء تدل على مدينة طنجة : السوق الداخلي، دار الدباغ، دروج المريكان، دار البارود..إلخ. وفي الوقت نفسه تدل كل الأحداث والأوصاف على أن المدينة تلك قد تكون أية مدينة عربية غارقة في همومها وتناقضاتها وحداثتها اللقيطة، وفقرها المذقع وغناها الفاحش وشبابها العاطل والمخدرات والعهارة وزد على ذلك : " أبناك، لصوص، إعلانات، حانات، شاحنات ، عمارات فخمة، شباك أوتوماتيكي معطل...دكاكين، كمبيوتر شله الفيروس، خراء كلاب يابس..عوسج غير مثمر....راقصات خلعن العذار..سادن هرب من الكعبة..رؤوس أكباش محشوة ..سردين مشوي.. بيرة.. الكبت الجنسي..حقائب..محطات..مطارات..دور الدعارة.. عجرفة.. دور ثقافة في عطلة دائمة.. واعد يرعد بوعيده..كوكاكولا...طاليان سي إن إن..موكب جنائزي...هجرة..زواج المتعة.. آذان الفجر.. عقار...فول سوداني مقلي..حمقى..." (ص. 36-37).
ولأن فضاء المدينة المعنية في النص يكاد يكون هو نفسه حيثما وليت وجهك في البلدان العربية، فإن السارد لم يتردد أن يشير بين الفينة والأخرى إلى أوجه الشبه بين مدينته ومدن أخرى (كالقاهرة أو اليمن) لا يذكرها بالإسم بل بأسماء أحيائها المعروفة : "رائحة مركبة طازج مثل تلك التي تتنعم بها في الحسين والإمام الشافعي والسيدة نفيسة والفسطاط ..." (ص. 15). "آلهة من لحم ودم تزين الكراسي كزملائهم في لؤلؤة الحسين والفيشاوي وفي شوارع صنعاء المفتوحة والمغلفة.." (ص. 18). يعلق السارد على هذا التشابه الصارخ بين فضاءات المدن العربية : " تعجبت متسائلا إن كانت هذه المدن قد وقعت اتفاقية توأمة" (ص. 15).
النص مقامات وسراويل. تبدأ المقامات بالخلوة والعزلة وتنتهي بمقام الفناء، وبينهما مقامات تغرق في التضاد مثلما تغرق المدينة نفسها في تناقضاتها الصارخة : مقام القبض والبسط، مقام الغيبة والحضور، مقام المحو والإثبات... لكل مقام مقاله الذي يكشف ويفضح ثم يدين بلهجة الغضب تارة والسخرية تارة أخرى. أما السراويل فهي على مقاس حجم المدينة وشوارعها وعوراتها.. سراويل الإدريسي القصيرة (استنادا إلى حجم الرواية ) تضيق حينا وتتسع أحيانا. لكنها تسقط شيئا فشيئا. تُعرّي المدينة وتكشف عن أسرارها : ثمة شخصيات من لحم ودم. أمريكيون يشترون طربوشا "يشبه طربوش الكوبوي مصنوعا من الجلد الرخيص بأغلى ثمن (...) الصنع محلي والخيال أمريكاني" (ص.16). إنها صورة الأمريكي السائح في طنجة. من قلة ما يسافر خارج أمبراطوريته يحن إلى كل ما يذكره بها وحين يجد مشابها له يقتنيه بفرح عارم. ثمة أيضا بائعو مخدرات بكل أشكالها ومرشحون للهجرة السرية وسيارات الأجرة وخادمات في الحانات وعاهرات. السراويل تسقط رويدا رويدا فتتشكل إثر كل سقوط لوحات بألوان رمادية قاتمة. لذلك جاء السرد متدفقا ومنساقا لإحساس السارد البطل بالأشياء والأمكنة في أقصى جزئياتها وحركياتها. الزمن نفسي إلى حد كبير، لأن التدفق السردي لا يأبه في نص الإدريسي بالخيط الزمني في تتابعه "المنطقي". وهكذا لن نتعرف عن حقيقة السارد البطل إلا شيئا فشيئا كأنه يتشكل وفق تتابع اللوحات الوصفية للأحداث. البطل هو أيضا يكشف عن خبايا نفسه تدريجيا، وحين يتعب من الكلام وعض الشفتين يمينا وشمالا من شدة الغضب أوحين يتعب من إطلاق النار من مسدسه الخيالي على السواح وسيارات المرسيديس الفاخرة وهو يصيح : "مافيا"، ثم حين يحس بالحرمان والغبن وحين تضيق عليه سراويل المدينة "العاهرة" برمتها، يقف وسط الشارع وينزع سرواله أمام الملأ : " خلعت سروالي على مرأى جميع آلهة كافي سنطرال وفونطيس وما جاورهما...دبري يشم الهواء..وليته..بدأت في البول على حائط البازار وأنا أغني." (ص. 35).
يلزم على القارئ أن يبلغ آخر سطر من الرواية كي يتعرف أ كثر على شخصية البطل ويعيد رسم مساره الإنساني في المدينة التي يمقتها الآن : فهو ينحدر من قرية محاذية للمدينة في أعلى الجبل. التقى بأنجليزي من أصل إسباني كان قد جاء إليها إبان عهد الاستعمار لدراسة الطيور "وقت سفادها وتوالدها وقطاعها (....) وأثناء هجرة الطيور إلى الشمال يدرس طيور المدينة الجديدة من غلمان ووولدان مخلدين" (ص. 41). هكذا سقط أحدهما في شرك الآخر، جمع بينهما لواط غير متكافئ المصلحة، لكن وجد فيه كل منهما ضالته. وبعد وفاة السيد وليام يرث السارد عنه حانة في المدينة ويصبح من الأعيان يتاجر "في اللحم والشحم والعظم والشاي والسكر والنعناع... في كل شيء..في بني آدم..في السيارات..في المخدرات..في المسكنات..في قوارب الموت.."(ص. 43)، إلى أن أصابه الإفلاس ـ هو الذي لم يرث عن السيد وليام إلى جانب الحانة حسن التدبير وثقافة إدامة الرأسمال ـ فيغدو متسكعا في شوارع المدينة. يبوح النص أيضا ببعض سفرات البطل إلى الخارج وغيابه عن المدينة لمدة سنوات تغيرت فيها أشياء كثيرة مما جعل منه غريبا مرتين : مرة خارج المدينة والبلد ومرة داخلهما.
العودة إلى الواقع المر كانت كابوسا مرعبا. نوعا من النزول إلى جهنم لشاب كانت له حانة إسمها : حانة الجنة في الأرض. إن الواقع الاجتماعي الذي يرصد تفاصيله الراوي بدقة ليس جديدا في الرواية المغربية خاصة والعربية عامة. لكن طريقة رصده هي ما يميز نص السراويل. لا تهم الأسماء. ولا حتى المهن التي تشغلها شخصيات أخرى في الرواية، مادام يجمع بينها انتمائها الاجتماعي الذي يحدد سلوكاتها ومصائرها. فالسارد البطل المتسكع قد يكون هو نفسه المهندس الزراعي الذي يشتغل أيضا سائق طاكسي في القاهرة، أو شابا عاطلا، أو ذاك المتسول الأعمى الذي لا يعرف حتى الراوي نفسه إن كان أعمى حقا. ثم ما معنى العمى؟ "نحن بأعيننا ولا نرى شيئا" يعلق الراوي (ص. 31).
هذا الغموض الذي يبقي عليه الروائي عمدا في الكثير من الصور والمشاهد ليس سوى رصدا أمينا حيا وصادقا لغموض العلاقات الاجتماعية التي يشوبها الكذب والنفاق والريبة والتحايل. هنا أيضا يكمن أحد أسرار المقامات في النص. إن بطل الرواية في أعين الناس متشرد وناقص عقل فقط، لكن الناس في أعين الراوي كلهم "مافيا" ولا ينقصهم البصر بل البصيرة. لذلك يدخل السارد فضاء الحكي منذ السطور الأولى منبها إلى اعتزاله الفضاء كي يروي (مقام الخلوة والعزلة) : "كان لزاما علي في آخر شأني وبداية حالي أن أتخلص من بعض العادات التي تعكر علي صفاء مقامي ومقام صفائي، وتحجبني عني" (ص.7). الحكي نفسه لا يرقى إلى مقامه الجمالي دون انتشاله من المألوف في تقنيات الكتابة الروائية العربية لغة وأسلوبا. ولذلك تنفجر اللغة هنا بكامل ثقلها الرمزي والبلاغي في حرية تلغي الحدود ما بين الفصيح والعامي، ما بين العامية المغربية والعامية المصرية، ما بين استحضار للشعر القديم والشعر الحديث والزجل والمثل الشعبي، ما بين إحالة إلى محمد عبد الوهاب منشدا لا تكذبي لكامل الشناوي أو الهوى والشباب للأخطل الصغير وأخرى إلى شخصية الرحالة ابن بطوطة وشخصية عبد الرحمان المجذوب وأشعاره في النساء. النص يستقي متعته أيضا من أسلوبه الساخر الذي عهدناه عند عبد اللطيف الإدريسي منذ مجموعته القصصية متاهات متقاطعة[2] : ( "لم يعد يهمنى إست الستات" ص. 12. "شاحنة صغيرة ذات ثلاثة مقاعد أمامية وسطح واسع (...) وكأنك تمتطي شاحنة عسكرية. طاقة حمْلِها ثمانية أشخاص أربعة مقابل أربعة. كانوا ثمانية، بالإضافة إلى بعض الحيوانات. ذكرني هذا الوضع بأغنية عبد الوهاب : عيناها في عينيه في شفتيه..في ذقنه..." ص. 24 . "لعن الله سائقي الحافلات، كلما طلبت منهم أن أصعد من الباب الأمامي، رفضوا وألحوا علي أن أصعد من الباب الخلفي مبررين قولهم بأنه ليس لي شيء زيادة يجعلني أتميز به عن باقي الخلق..كالقرون مثلا" ص. 32.....).
كل هذه السمات الإبداعية في رواية الإدريسي جعلت من سراويل المدينة نصا جذابا يقرأ دفعة واحدة. يقول عنه القاص المغربي أحمد بوزفور في تقديمه للكتاب إنه "نص غريب (...) والغرابة أو الغربة نابعة أيضا من سرده المتفجر النافذ المهلوس الممرور الساخر (...) سرد لا يحفل بكمال الجمل ولا ببهائها ولا بروابط الوصل بينها، بقدر ما يحرص على دقة الصدق وحرارة الحياة" (ص. 6).
![]()
![]()
![]()
[1] سراويل المدينة، عبد اللطيف الإدريسي ، دار ميريت ، القاهرة، 2008.
[2] منشورات سلسلة أبجد، الدار البيضاء، 2005.