قراءة في رواية ( العين الثالثة ) للدّكتور حبيب مونسي

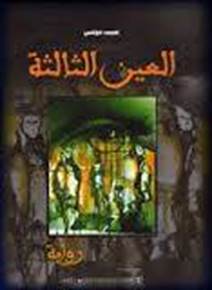
مدخل..
( العين الثالثة ) للأديب الرّوائي حبيب مونسي رواية فلسفيّة بامتياز ، تطرح كثيرا من الأسئلة بل طوفانا من الأسئلة ، تجعل الذّهن يتّقد والفكر يتأجج ، وتسرح في مفهوم الزمان والمكان ، وتتجوّل في أبعاد الذّات الإنسانيّة غير المكتشفة ، قرأتها بمتعة هي فوق الوصف، البعد الفلسفي فيها امتزج بالأدبي والنقدي ، فالتحما التحاما عضويّا متينا، وغلبت الفلسفة على الحبكة والعقد المشوّقة التي يمكن أن تستهوي عامّة القرّاء ، ولذلك فهي رواية تستقطب بالأساس الطبقة المثقّفة من القرّاء ثقافة عالية .. هي رواية في 154 صفحة ، صدرت عن مكتبة الرّشاد للطباعة والنّشر والتوزيع ( الجزائر ) عام 2009 م.
اختزال إجباري:
هو يشبه إلى حدّ ما عملَ مَن يطوي مضلّة الهبوط الضخمة في حقيبة ظهر صغيرة ، ثمّ يعمل على فتحها في الوقت المناسب ، لينزل إلى الأرض نزولا آمنا بعد أن يشبع روحه من متعة التحليق ، ذلك ما سأحاول القيام به مع رواية ( العين الثالثة ) للدّكتور الأديب حبيب مونسي ، هي رواية فلسفيّة تروي قصّة شاب دخل السّجن خطأ، إذ أنّه وجد يُعتقل نفسه وهو يمشي بين جماعة مشاغبة من مشجعي إحدى الفرق الرّياضيّة ، وكان مصيره أن تزج به الشرطة في السّجن ومعه رجلان، أحدهما كهل والثاني شاب..
ووجد نفسه بين أربعة جدران محبوسا مثل اللّصوص والمجرمين ، لا لشيء فعَلَه ولكن لحكمة الأقدار التي وضعته في هذا الموقف الصّعب ، وبدلا من أن يغضب ويسخط أو يحتجّ ، نظر إلى الأمر من زاوية مختلفة ، حاول التأقلم مع المكان والتفكّر في مدلولات مضيّ الزمن ، إنّها فرصة لفهم الحياة أكثر من خلال لحظة سكون إجباري..
في تلك الأثناء نام بعمق فرأى حلما غريبا ، فلما أراد أن يقصّه على رفيقَيه ؛ فوجئ بأنّهما رأيا الحلم نفسه ، وهنا يتغيّر مسار القصّة ، ويدخل فيها بطل ثانٍ ، بطل الحلم الذي رآه السجناء الثلاثة ، وهو شاب يعمل في بعض دوائر الأرشيف الحكوميّة ، وفي لحظة ضعف قام بتسهيل بعض المعاملات المشبوهة ، ليحظى بصفقة العمر التي تنتشله من دائرة الفقر ، ويحقق الحلم العظيم في الحصول على الثلاثي الذي يتطلّع إليه كلّ شاب ؛ ( المرأة / السّكن / السيّارة ) ، ولكنّه في نهاية المطاف يجد نفسه موقوفا ليزجّ به في السجن ، ثمّ يكتشف لاحقا أنّ جماعة ( اللّصوص الكبار ) هي من استدرجه ودبّر له ذلك الأمر ، فيعقد العزم على الانتقام منهم ، ومحاربتهم بأسلحتهم فقد أخذ كامل احتياطاته من قبل، وجهّز الملفّات اللازمة التي تُدينهم ، ويؤنّبه ضميره وتستيقظ الأخلاق التي كاد يقبرها في صدره ، فيرفض كلّ عروض الإغراء والإغواء التي تُقدّم له البراءة والحريّة والترقيّة في منصبه على طبق من ذهب، شريطة أن يكون متعاونا ويدخل الصّف مع جماعة ( اللصوص الكبار ).
يصرّ على موقفه ويزجّ بكثيرين منهم في السّجن ، لكنّه في النهاية يلقى المصير المحتوم ، فقد وُجد ذات صباح مشنوقا بزنزانته ، ويرى السجناء الثلاثة الذين دخلوا الزنزانة نفسها بعد موته بثلاثة أشهر يرون تفاصيل قصّته في حلم مشترك ، كلّ واحد منهم يكمّل حلم الآخر ، ويأسفون في نهاية المطاف لموته ، لكنّ بطل القصّة الأوّل الذي هو في الأصل مدمن قراءة روايات ؛ يقرر الانتقام بطريقة عجيبة، وهي أن يكتب قصّته ويوصلها إلى النّاس ..
تلخيص قد يفي إلى حدّ ما بوقائع الأحداث ( الظاهريّة ) ، لكنّه لا يقدّم شيئا كبيرا من فلسفة الرواية العميقة ، وأسئلتها الكبيرة التي تطوّح بالرؤوس ذات اليمين وذات الشمال ، وتفصيل ذلك في القراءة المتأنيّة والتحليل المتتبع لعمليّة السّرد بشيء من التفصيل وإلقاء الأضواء الكاشفة.. !
في المضمون:
الرواية لا تقدّم حدثا معتادا كما يصرّح بذلك المؤلّف نفسه أثناء عمليّة السّرد ، بل تقدّم فلسفة فهم أبعاد المكان والزمان والنّفس البشريّة في أصغر وأبسط تفاصيل الحياة ، ومن زاوية خارجيّة سمّاها المؤلّف ( العين الثالثة ) .. وهي العين التي قال عنها :
" .. المهم أن يعلم الواحد منّا أنّه إذا خالف طبيعته صار مسخا حقيرا مقرفا .. وأنّك إذا دققت في النّاس ونظرت إليهم بالعين الثالثة رأيت الشوارع تكتظ بالمسوخ وهم يترنّحون في مشيتهم بين اختلال في الوزن ، وتشوّه في البنية ، وكأنّك تطلّ على لوحة من لوحات الجحيم .." ص 153.
فالعين الثالثة هي رؤية خارج الذّات من بُعد آخر مختلف، تجعل الإنسان لا ينغمس في حمأتها ، بل يراها من مكان مرتفع فيرى كلّ البشاعة والسّوء الذي فيها بعين ثاقبة ، حتى ولو كان هو أحد مشاريع ( المسوخ ) التي تعبّ في الحمأة.. !
سحر العنوان:
عنوان الرّواية يحمل كثير من السّحر والجاذبيّة ، لكونه ينطوي على شيء من الغموض ودهشة التساؤل ، ترى ما هي العين الثالثة ؟ ما المقصود بها ؟ وما تخفي وراءها ؟ وهو تساؤل مشروع يطفو إلى ذهن كلّ متلقٍ ينطبع العنوان في ذهنه لأوّل وهلة ، ويبقى السؤال عالقا إلى آخر صفحات الرواية حتّى يفضي المؤلّف بشيء من ظلال ذلك العنوان..
وفي العنوان نفسه دعوة إلى رؤية مغايرة ، تستبعد المعتاد والركون إلى المألوف أو الانسياق مع التّيار ومسايرته ، هي دعوة إلى رؤية ثاقبة بعين البصيرة ..
الإطار الزماني والمكاني:
بما أنّ الرّواية تناقش مسألة مفهوم المكان والزّمان فلابدّ من التعرّف على الفضاء الرّحب لهذا المفهوم داخل الرواية..
الفضاء الزماني:
لم يحدّده السّارد بدقّة .. أقصد أنّه لم يحدد سنة ولا شهرا أو يوما ، بل لم يحدّد حتى العصر بشكل مباشر، لكنّه يفهم من خلال سياق تطوّر الأحداث ، وبعض دلالات الألفاظ التي تشير إلى الزمن المعاصر ، مثل فرق تشجيع كرة القدم ، وعالم الإدارة والأعمال التي لم تعرف بشكلها الذي نعرفه الآن إلا في زمننا المعاصر..
ذلك لأنّ المؤلّف يناقش مسألة الزّمن بمفهومها العام الذي لا يمكن أن ينحصر في عصر دون عصر، أو حقبة دون أخرى ، فالبطل مثلا الذي كان غارقا في عالم الرّوايات يقرأها بنهم ويقبل عليها بشراهة، كان الزمن عنده يجري بتدفق كبير كان الزمن عنده ضوئيّا ، لا يكاد يكفيه لإنجاز طموحاته ورغباته في قراءة كم كبير من الروايات ، ومن هنا فالزمن عنده سريع خاطف ، خفيف الظّل لا يكاد يشعر بمروره ..
في حين أنّه لمّا أُلقي به في الزّنزانة صار عنده فائض من الوقت ، وصار الزمن يمرّ ثقيلا متباطئا ، حتّى أنّ رفيقَي السّجن دعواه إلى قتل الزمن بالمشاركة في لعبة الورق التي كانا منغمسين فيها ، حتى لا يشعرا بثقل الزمن ووطأته.. وهنا التفت البطل إلى الفرق في الشعور بالزمن بين حياته قبل السجن وحياته داخل السجن ، يقول المؤلّف في ص 06 :
" لقد كان هذا الشعور الغريب ، المعضلة الكبرى التي جعلتني ألتفت إلى الزمن، لأرى فيه صورة جديدة، بعيدة عمّا كنت أألف فيه في سابق أيّامي.. كنت كثيرا ما أقلق من سرعة تحوّله وذهابه، وأنا أقلّب أوراق الرواية. فأرفع بصري إلى ساعتي متذمرا، وأعد نفسي بزمن أطول أتلذّذ فيها بما انبسط أمامي من مشاهد مختلفة، وبما خالط نفسي من أحداث الرواية من مشاعر وأحاسيس، لقد كانت دورة الأفلاك سريعة، تطوى فيها السّاعات والأيّام على الهيئة التي أطوي فيها الأوراق والفصول. غير أنّ للزمن اليوم شأن آخر لم أكن أتصوّره من قبل، أرى فيه العذاب الذي لا عذاب أشقّ منه ولا أكبر.."
والجميل أنّ البطل يحاول التأقلم مع هذا الزمن البطيء الثقيل ، ويحاول استثماره ، إنّه فرصة لتأمّل الزمن والذّات والكون من حوله ، فرصة لإعادة قراءة الحياة من جديد ، بطؤ الزمن وثقله أفضل من الارتماء في لعبة الورق التي تغرق صاحبها في الوهم والمشاعر المتناقضة ، يقول المؤلّف على لسان بطله بعد ذلك في صفحة 09 :
" .. أفضّل سحق الزمن على أن أنصاع إلى داعي اللعب بالورق.. كنت أفضّل أن أواجه كبرياء الزمن وجها لوجه، بدل أن تطوّح بي دوّامات الورق المتطاير في آتون المشاعر المتناقضة التي أقرأها في وجهي اللاعبين.. "
الفضاء المكاني:
بالنّسبة للمكان كان السّجن هو البؤرة الرئيسيّة التي تدور فيها الأحداث ، ثم تنداح بعد ذلك إلى خارجه لتمسّ إدارة الأرشيف حيث يعمل بطل القصّة الثاني ، أين تنسج خيوط قصّة ثانية داخل القصّة الأولى ، ويصير البطل الأوّل ما هو إلا قناة موصلة إلى البطل الثاني عبد الحقّ ، الذي تشغل أحداث حياته معظم حجم الرواية..
لكنّ المكان هنا أيضا له بعد فلسفي عميق لا ينحصر بين أربعة جدران ، بل يكاد يتجاوزه إلى المفهوم المطلق للزمن ، بحيث يكون الانتقال إليه بالاسترجاع أو الرؤيا ، أو الحوار وفي هذه النّقطة بالذّات يلتحم الزمان بالمكان ، ولا يصير بينهما إلا فارق دقيق كحدّ الشعرة ، ولعلّ المكان لا قيمة له بغير الزمان، ويصلح الحكم نفسه في الزمن وتحوّلاته ، فلا مكان بغير زمان ولا زمان بغير مكان.. !
وقد عبّر الكاتب عن ذلك بالحديث عن التجلّي الذي حدث لدى بطله حين قال:
" وكأنّ الفتى قد عثر في الزمان والمكان على فتحة تتيح له السّفر عبرهما إلى عوالم غريبة "
كأنّه حلم كأنّه رؤيا، كأنّه عبور إلى عوالم أخرى خفيّة تدخل ضمن قول الله تعالى " ويخلق ما لا تعلمون " ، ولكي يتضح الأمر أكثر أو ليتعقّد أكثر يقول المؤلّف ص27 :
" كنت أريد أن أسأله عن المكان وسلطته ، وعن الزمان وقهره، وهل يتعذّر علينا أن ندرك حقيقتهما إلا في مثل تلك الأمكنة.. لم أجد الشجاعة لتسمية المكان باسمه. ورأيت ابتسامته الشاحبة ترتسم على شفتيه ، وكأنّه يقول لي ليس في الأسماء ضير .."
وهذا يفضي بنا إلى الحديث عن شخوص الرواية..
البناء الفنّي لشخوص الرّواية :
يظهر في الرّواية بطلان أساسيان ، لم يشأ المؤلّف أن يسمّي الأوّل منهما ، ولا بقيّة شخوص الرّواية ، إنّما سمّى البطل الثاني لرمزيّة اسمه ودلالته العميقة ( عبد الحقّ ) ، وقد ناقش الرّاوي معضلة تسمية الشّخوص ، وكسر بذلك آلية السّرد المتلاحق الذي يختفي فيه الرّاوي أو ( المؤلّف ) خلف الأحداث، ووقف مرّتين أو ثلاث يناقش المسألة قبل استئناف عمليّة السّرد ، وسنعرض لذلك في حينه عندما نتحدّث عن الأسلوب السّردي.
البطل الأوّل :
كان هو الرّاوي نفسه للأحداث ولم يذكر اسمه في الرّواية ولم يحفل المؤلّف بصفاته الجسديّة ، لكنّه ذكر جملة من صفاته التي تدلّ على شخصيّته ، من خلال حديثه عن نفسّه ، إذ كان مدمنا على القراءة عاشقا للرّوايات يكره لعبة الورق ويرى أنّها مضيعة للوقت ، بل هي أكثر من ذلك هي تشبه إلى حدّ ما الشيطان الصّغير الذي يتلاعب بعقول اللاعبين ، يقول في ص 05 :
" لقد كانت لعبة الورق، في مقابل القراءة مضيعة للوقت، وتبديدا للجهد فكنت كلّما رأيتها أنفر منها ، وألوذ سريعا بالعوالم التي تتكشّف أمامي في صفحات الرّوايات.."
ثمّ يقول في ص 08 :
" لقد كانت ( أوراق اللّعب ) في نظري – وأنا أرقب رفيقيّ – شيطانا ضعيف البنية ، هيّن القوام ، إلا أنّه أصلب من العناد نفسه.."
فالبطل هنا يظهر شخصيّة مثقفة ملتزمة جادّة، لا ترى في الحياة لعبا أو لهوا يضيع فيه عمر الإنسان، ولعلّ المؤلّف هنا أضفى على البطل شيئا من شخصيّته هو ، وجزءا من تفكيره وخصائصه النّفسيّة[2] ، التي تقول بضرورة النّظر في النّص بمعزل عن مؤلّفه ، طلبا لشيء من الموضوعيّة أو أنّ النّص صار قائما بذاته ( كائنا حيّا ) لا نحتاج معه إلى مؤلفه ليشرح لنا أو يفسّر ، أو لنفهم بعض مدلولات النّص من خلال التّعرف على حياة المؤلّف ومعرفة السياق الذي كتب فيه نصّه ذاك ، وما إلى ذلك من خصائص شخصيّة بيئيّة تكون ظلالها موجودة في النّص ، وهي نظريّة فيها كثير من الشطط بلا شك ..
والمؤلّف هنا يقول لنا بكل جرأة وظهور مباشر أنا هنا ، أنا من يدير دفّة الأحداث ويحدّد وجهتها ..! ثمّ يعرض لقضيّة هامة جدّا في بناء المعمار الرّوائي ، وهي قضيّة تسميّة الشخوص ، هل من الضرورة أن نعطي للشخوص أسماء معروفة متداولة أو حتى غريبة غير شائعة ..؟ ما الفرق بين أن نسمّي البطل مصطفى أو أحمد ؟ وبين أن نسميه س أو ك ..؟
هنا مسألة تحتاج إلى نظر .. !! بعض الكتّاب يلتزمون بالأسماء المعروفة التي يسمّى بها النّاس ، وبعضهم يلجأ إلى الأسماء الغريبة ، لكنّ آخرين لا يسمّون مطلقا ، وينجح ذلك كثيرا في القصّة القصيرة ، وحتّى في الرواية إذا كان عدد الشخوص محدودا ، لاسيما إذا كان ضمير السّرد المستعمل هو ضمير المتكلّم ، لكنّه في الغالب يحتاج إلى تسمية المخاطَبين إذا احتاج إلى محاورتهم ، ولو بأسماء مهنهم أو أوصافهم الغالبة عليهم..
وقد ناقش المؤلّف هذه القضيّة فقال:
" إنّ الأسماء قد تخون حقيقة الموضوع ، فما معنى أن يسمّى هذا سعيد ، وذاك فؤاد ، وتلك وداد، ولا شيء من الأسماء ومعانيها ينطبق على الموضوع .. إنّنا حين نلجأ إلى إلصاق الصّفات كمسمّيات نعبث بالمعقوليّة في تصميم عقلانيّتها .. نعبث بالمصير ذاته .."
ثمّ يتساءل في حيرة وقلق ص 48:
" هل ألجأ إلى تعيين الأوّل والثاني برقم أو حرف كما فعلت الرواية الحديثة استخفافا بالشخصيّة في أعمق مميّزاتها ؟ هل استمرّ فأقول الرّجل الكهل والرّجل النّحيف البليد ؟
لا .. سأترك الأمر للرّاوي يفعل بهما ما يشاء، يكفي أن أقرأ رواية كلّ واحد منهما .."
ورغم أنّ المؤلّف يرى أنّ الرواية الحديثة عندما تلجأ إلى تسمية شخوصها بأرقام أو حروف فإنّها تستخفّ بالشخصيّة الرّوائيّة ؛ إلا أن أنّه يسلم أمره للراوي والذي بدوره يبقي على تسمية رفيقي السجن بالكهل والرّجل النحيف البليد ، ويسمّي الشخوص الآخرين بــ ( س / ف /ك ) ، ويبدو أنّ المؤلّف لجأ إلى ذلك ليحطّ من شأن تلك الشخوص فعلا ، وكأنّه جعل التسمية درجات ، البطل الأساسي الثاني سمّاه ( عبد الحقّ ) و السجينان الأقل جرما سماهما ( الكهل والشاب النحيف ) أمّا المجرمون المحترفون فقد رمز لهم بحروف للتحقير من شأنهم ، كما فعلت الرواية الحديثة ، ولأنّ البطل الأوّل جعله راويا وهو ينوب عن المؤلف نفسه ، اكتفى بتسميته ( الفتى )..
استنتاج قد لا يكون المؤلّف قصده بتاتا ، لكن ما يشجعنا على طرحه ولو من باب قراءة لا شعور المؤلّف ؛ هو أنّ المؤلّف أستاذ جامعي يشتغل بالنقد الأدبي لسنوات طويلة جدّا وألّف فيه الكتب العلميّة والتنظيريّة المستفيضة ، ويتعامل مع الرواية والنّقد الأدبي يوميّا في الجامعة.. وأظهر ذلك بعد أن كتب أكثر من ثلث هذه الرواية .. !
واحتمال آخر – وقد يكون ضعيفا – وهو لجوء الكاتب إلى التّسمية بالحروف تجنّبا لأي تشابه محتمل في الأسماء القريبة من محيطه ، تفاديّا للحرج أو التأويلات التي تسيء إلى زيد أو عمر ، وتوقع المؤلّف في ( حيص بيص ).. !
ونؤكد أمرا أشرنا إليه وهو أنّ هذا الظهور البارز للمؤلّف في ثنايا عمليّة السّرد له نتائج متباينة على القارئ والمتلقّي ، سيتلقّاه القارئ المتخصص ( الدّارس والنّاقد ) بعناية كبيرة وسيثير في نفسه كثيرا من الأسئلة ، ويجعله يقلّب الرّأي على كلّ وجوهه ، وقد يستطرفه القارئ العادي ويبتسم له ، لكنّه في الوقت نفسه قد يربكه ، ويجعله يعيد قراءة الفقرات التي يبرز فيها المؤلّف ويُبين عن خصيّته بشكل علني ، فيحاول التأكد إن كان ذلك هو المؤلّف أم الرّاوي أم هو وسيط آخر داخل الرّواية ، وقد يحدث الأسوأ ، فيفقد القارئ حماسه للرواية وينصرف عنها .. ولذلك قلتُ في البداية هذه رواية موجّهة إلى فئة معيّنة من القرّاء ، بسبب الشحن الفلسفي الذي زخرت به ، وبسبب هذا الذي يعدّ قضيّة أدبيّة نقديّة تُناقَش ضمن إطار السّرد الرّوائي .. !
فأمّا عن نفسي فقد راقني الأمر كثيرا وجعلني أقف عنده مطوّلا ، وأتمّلى أبعاده المختلفة في البناء الروائي ، وفي تأثيره على المتلقّي ، وجعلني أيضا أتساءل إن كان بإمكان الرّواية أن تساهم في التنظير الأدبي ، وتثري العمليّة النقديّة وتثير قضاياها داخل المتن الروائي أو القصصي نفسه..؟؟
ثراء ثقافي وتنوّع فنّي:
في الرّواية حشد قيّم من الاقتباسات الثقافيّة وشيء من التناص والتطعيم بالأمثلة والحكم ، التي تجعل من النّص غنيّا وضاجّا بالحياة الثقافيّة التي تغري كلّ قارئ ، وتحبّبه في النّص فلا يخرج منه إلا وقد أخذ حصيلة جديدة من فكر أو فنّ وثقافة ، ونسوق من ذلك هذه الأمثلة المتنوّعة:
ذكر الكاتب الغول والعنقاء في سياق الحديث عن مخاوف الإنسان فقال في ص 28:
" صحيح ما الغول والعنقاء .. إلا أسماء لأوهام الإنسان الخائف المتردّد بين الظلمة والنور .."
في سياق الحديث عن حقيقة الخوف التي انغرست في ذهن الإنسان ، يستعير الكاتب من التراث العربي أسطورة الغول والعنقاء ، ليوضّح الصورة الفلسفيّة التي يَبْسُط مفهومها بشكل مُبَسّط ، إذ أنّ الخوف ما هو إلا خرافة عريقة في الشعور الإنساني ، سيطرت عليه منذ آلاف السنين ، وهي تشبه إلى حدّ بعيد أسطورة الغول والعنقاء ، والاستعانة هنا بالتراث العربي له دلالة الانتماء ، ودلالة الاغتناء بالتراث العربي ، فبدلا من أن يلجأ إلى الأساطير اليونانيّة والإغريقيّة الشائعة في كتابات كثير من كتّابنا ومؤلفينا الذين تأثروا بالثقافات الأوربيّة ؛ فإنّه ينحاز إلى الثقافة العربيّة ، ويغني بها روايته.
كما يستعين كذلك بالمثل الشعبي :
" من خاف سلم " وهذا نوع من التنويع بين الفصيح والدّارج ، والاستمداد من عمق الثقافة الشعبيّة، لاسيما تلك الثقافة التي لا تنبتُّ عن أصولها الأولى فالمثل ( من خاف سلم ) هو في أصله فصيح ، ولعلّ له سندا في أمثال العرب.
وسبق الإشارة إلى استحضار المؤلّف لشعر أبي العلاء المعرّي حول رأيه الفلسفي في الحياة والموت. وحَضَر التناص مرارا ومن أمثلته قوله في ص 60:
" وتطير نفسه شعاعا .." وهي صورة فنيّة نادرة أظنّ أنّ أقدم من سُمعت منه هو الشاعر قطريّ بن الفجاءة في قوله:
أَقولُ لَها وَقَد طارَت شَعاعاً * * مِنَ الأَبطالِ وَيحَكِ لَن تُراعي
فَإِنَّكِ لَو سَأَلتِ بَقاءَ يَومٍ * * عَلى الأَجَلِ الَّذي لَكِ لَم تُطاعي
ومن التناص أيضا وجدت قوله في ص 67:
" يحسب كلّ صيحة عليه " وهو وصف دقيق وبارع يبيّن حالة ( الـمُرِيبين ) ، استعاره من القرآن الكريم ، من قوله تعالى في سورة ( المنافقون ) :
" يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ " من الآية الثامنة ، وهذه الخاصيّة الفنيّة تطبع أغلب أسلوب الدّكتور حبيب مونسي ، فهو متشبّع بالثقافة القرآنية متشرّب بلمساتها الجماليّة ، ولا غرابة في الأمر فهو صاحب كتاب ( المشهد السّردي في القرآن الكريم )
[2] - هي نظريّة جاء بها رولان بارت ( 1915 / 1980 م ) ، وهي في الحقيقة ليست بشيء ، ولا بأمر جديد ، فعندنا في التراث العربي (انظر إلى ما قيل لا إلى مَن قال ) ، وهي لها زاوية إيجابيّة ، ولكن لها أيضا جانب سلبيّ بالنّسبة للمتلقّي. فليس كلّ إنسان يستطيع أن يفصل بين القول وقائله، وإن كانت المقولة في نفسها صحيحة ، لكن جرت فطرة الإنسان أن يقتدي بالعمل قبل القول.
[3] - المشهد السّردي في القرآن الكريم من منشورات ( مكتبة الرّشاد للطباعة والنّشر والتوزيع ) عام 2009 م
وسوم: العدد 698