دراسات في تاريخ الفكر السياسي الإسلامي
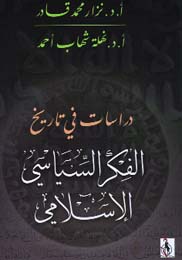
يبحث كل من نزار محمد قادر ونهلة شهاب أحمد في كتابهما «دراسات في تاريخ الفكر الإسلامي»، في القضايا التي تناولها التراث الإسلامي السياسي، عبر مجموعة من الإعلام الذين اهتموا بالشأن السياسي الإسلامي، ولاسيما الإمام الباقلاني والإمام الماوردي وابن حزم الأندلسي وأبي الوليد الطرطوشي وابن الأزرق، بالإضافة إلى بعض رجال السياسة والوزراء ـ الدولة العباسية ـ، ولاسيما أحمد بن نصر الخزاعي والوزير يحيى بن محمد هبيرة.
ويركز الباحثان في كتابهما على مسألة الخلافة والإمامة وأصول الحكم، ناهيك عن الخلافات السياسية التي نشأت بين جمهور المسلمين بعد وفاة الرسول (ص)، والتطورات العسكرية التي أدت إليها تلك الخلافات. كما يلقي الكتاب الضوء على الخلفية الفكرية والسياسية والاجتماعية لتلك الخلافات، ووجهة نظر الفقهاء في تلك الخلافات.أما الهدف من هذا الكتاب فهو تبيان أثر الواقع السياسي وتطورات القوى السياسية المختلفة على خارطة العالم الإسلامي، في موقف الفقهاء خلال مدة القرون الأربعة الساخنة في تاريخ الإسلام ـ من القرن الرابع الهجري وحتى القرن الثامن ـ بالإضافة إلى ما فعله الفقهاء من استيعاب لمتطلبات عصورهم ومحاولتهم إقامة نظرية دستورية داخل الفكر السياسي الإسلامي.
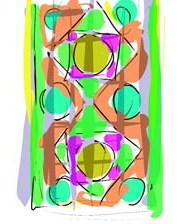
وما انتاب هذه النظرية خلال مراحل تطورها من تغيرات بسبب متطلبات كل عصر، وتأثيرات مختلف الأحداث. الأمر الذي سمح للباحثين بوصف الفكر السياسي الإسلامي بأنه فكر ديناميكي متجدد متفاعل، وليس فكراً نظرياً مجرداً مفترقاً ومتقاطعاً مع واقعه كما وسمه البعض.
أما ظهور الملامح الأولى لنظرية دستورية في الإسلام فكان مع الإمام الباقلاني، الذي سمحت له غزارة معلوماته وحسن فقهه وخبرته في الجدل، بأن يضع نظرية في شروط وأحكام الخلافة.
وفي الحالات التي توجب خلع الإمام وسقوط الطاعة، وفي الأسس القانونية وواجبات الإمامة. لينتهي الباقلاني من مناقشاته إلى أن الإمامة بالاختيار وليست بالنص لأنها قضية مصلحية يعود تقريرها للبشر، مستنداً على فرضية مؤداها «إذا فسد النص صح الاختيار»، وهذا يؤدي إلى أنه يمكن الأخذ بإجماع الأمة.
ويذهب المؤلفان إلى أن الباقلاني كان يهدف من وراء اجتهاده هذا إضفاء الشرعية على الخلافة العباسية، باعتبارها استمراراً طبيعياً للخلافة الأولى القائمة على الاختيار، وتجريد الخلافة الفاطمية من هذه الشرعية، على اعتبار أن الفاطميين ينطلقون من ان الإمامة بالنص وليس بالاختيار.
ومع الماوردي حقق الفكر الإسلامي قفزة كبيرة في طريق الوصول إلى نظرية دستورية ناضجة. حيث تجاوز التشريع للخلافة إلى التشريع لدولة إسلامية، من خلال طرحه لمشروع سياسي محدد الأهداف واضح المعالم.
أما المنهج الذي اتبعه الماوردي في بناء نظريته السياسية فهو إيجاد مجموعة من القواعد الفقهية النظرية لحل المشكلات السياسية أولاً، ثم ربط قضية الإمامة بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ثانياً.
أما أهم إنجاز سياسي يحسب للماوردي فهو تأكيده على ضرورة إعطاء صلاحيات واسعة لأمراء الأقاليم والأمصار. وحجته في ذلك أن مثل هذه الصلاحيات تبقي الأمراء تابعين للخلافة ومحافظين عليها طالما أن لهم دوراً كبيراً فيها. ويبدو أن مثل هذا الأمر هو الذي أعطى الخلافة العباسية مزيداً من القوة والاستمرار.
ولا يكتفي الكتاب بتناول الفكر السياسي في المشرق الإسلامي بل تناوله أيضاً في المغرب الإسلامي، وذلك للوقوف على مدى تأثر الفقهاء بأقرانهم في المشرق وكيفية انعكاس واقعهم على موقفهم من الإمامة. فعدم الاستقرار السياسي والخلافات شبه الدائمة بين دويلات الأندلس، انعكس على موقف الفقهاء ودفعهم إلى إعطاء الأولوية لواجب انقياد الأمة لإمام عادل.
ويبدو أن هذا الأمر هو الذي دفع بابن حزم الأندلسي للقول: «الأمة واجبة شرعاً وعقلاً وإجماعاً، فلا يحل بقاء ليلة دون بيعة»، مما يعني رفضه لاستبدالها بأنظمة سياسية أخرى، ومعارضته لوصاية الحجّاب على الخلافة كما حصل مع الخليفة هشام بن الحكم المستنصر والحاجب أبن أبي عامر.
أما أبي وليد الطرطوشي الأندلسي، الذي عاش في القرن الخامس للهجرة، فإنه يقدم قراءة مستفيضة لأوضاع عصره وطبيعة أنظمته السياسية، يعالج من خلالها أوضاع الأمة بالاعتماد على استنباط الحلول من الشرع والسوابق التاريخية.
أما ابن الأزرق الذي عاش في القرن التاسع الهجري، فنجده يؤكد على تجسيد السلطة المطلقة بيد السلطان دون أن يكون مسؤولاً أمام أحد، ولذلك نجده يستثمر قدرته على الاجتهاد ليوسع في حدود سلطة الملوك لتشمل كل شيء تقريباً متجاهلاً أي حقوق للرعية، الأمر الذي سمح بوصفه بأنه من فقهاء البلاط.
الكتاب: دراسات في تاريخ الفكر السياسي الإسلامي
تأليف: نزار محمد قادر ونهلة شهاب أحمد
الناشر: دار الزمان سوريا 2009
الصفحات: 199 صفحة
القطع : الكبير
![]()
![]()
![]()