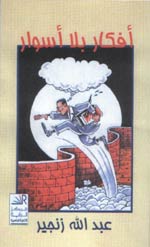أفكار بلا أسوار
أفكار بلا أسوار
|
|
المؤلف: عبد الله زنجير بقلم: د. وائل مرزا* |
إلى أي درجة يعيش الكاتب والمثقف هموم عصره وزمانه؟
هذا هو السؤال الذي تفرق الإجابة عليه بين كاتب وآخر وبين مثقف وآخر في هذه الأيام التي أُتخم فيها الواقع العربي بالكتابات.
ففي عصر تتوالد فيه منابر الإعلام والتعبير والرأي والصحافة كالأرانب كل يوم، أصبح المجال مفتوحاً لكل من (يرغب) في أن (يُعلن) نفسه مثقفاً أو كاتباً صحفياً لكي يُغرق العرب والمسلمين بطوفان من آرائه وأفكاره، ولم يعد ضرورياً في كثير من الأحيان أن يكون في تلك الأفكار (جديد) أو (مفيد) أو تتوافر فيها شروط (التوازن) و(الموضوعية) و(المنهجية) وإنما أصبح المهم اليوم أن يكون المرء ماهراً في العلاقات العامة، وأن يمتلك قدرة على إقامة صلات متميزة مع مدير مؤسسة إعلامية هنا ومع ناشر هناك، لكي يتم فرضه فرضاً على القارئ والمشاهد والمستمع، بحيث تتبلور ظاهرة (المثقف الإجباري) في ساحتنا الإعلامية والثقافية العربية كواحدة من تلك الظواهر الفريدة التي يتميز بها العرب دون غيرهم من الشعوب والأقوام على هذه البسيطة.
في مقابل تلك الصورة يأتي العطاء الذي يطرحه الأستاذ عبد الله زنجير في هذا الكتاب ليكون شاهداً على منهج في الكتابة والتفكير يتمحور حول هموم العصر والزمان، وبالتحديد حول هموم الأمة التي ينتمي إليها مؤلف الكتاب، بحيث يصلح الكتاب في تنوع مواضيعه لأن يكون قاموساً يشير إلى الخيوط التي تشكّل بمجملها نسيج همومنا العربية والإسلامية، فمن العولمة إلى الأقصى، ومن منهج الأقصى، ومن منهج الإمام الغزالي إلى الحديث عن الثقافة الذكورية، ومن هموم العراق إلى مضار التدخين، ومن هموم اللغة العربية إلى هموم الشباب، إلى غير ذلك من المواضيع، ينتقل المؤلف بقرائه من محطة إلى محطة، ليقف بهم عند كل واحدة منها وقفة رشيقة سريعة، يهدف من خلالها إلى إعطاء جرعة من المنهجية هنا، ورشفة من التوازن هناك، وشيء من التأصيل هنالك.
ومؤلف الكتاب مشغول خاصة بهمّ العرب في كل وطن من أوطانهم، ولذلك تراه يلامس بعض الهموم الخاصة لتلك الأوطان بأسلوبه الخاص، الذي يركز على ممارسات تمثل شيئاً من الإشراق في زمن العتمة، وبقعاً من الضوء في ظلمة الليل البهيم.. كما يفعل مثلاً عندما يشيد بالتطورات الدستورية في البحرين. ولكن محاولته لتشجيع الخير الكامن في تلك الممارسات لا تجعله غائباً عن حقيقة وجود السلبيات، وعن توافر إمكانية التطوير على الدوام، من هنا فإنه لا ينسى أن يمرر النقد المطلوب، ولكنه يمرره في صورة عتاب رقيق ينسابُ بين العبارات مثل النسيم اللطيف، بعيداً عن أسلوب المهاترات والاتهام والتشنيع الذي يمارسه كثير من أدعياء الثقافة والكتابة.
فالكويت، كما يقول المؤلف، كانت "ملاذنا الثقافي الدافئ بعد فتنة لبنان" ولكنها مدعوة حسب قوله لأن "تعود لجلبابها الحقيقي.. لأن البطولة هي في قدرتها على السمو والعفو"..
أما قطر فإن "سمعتها البراقة من المحيط إلى الخليج، برهان على كياستها وقدرتها المتفوقة على قراءة الخريطة" ولكن رغم ذلك فإن من "المطلوب أن تكون نصاعتها الداخلية مثل بريقها الخارجي"..
وكذلك الأردن الذي يراه المؤلف "قلباً عزيزاً ينبض بالفداء والمضاء بطول قامته وجذوره المنبثقة من أعماق التاريخ" ومع هذا فإنه لابد من "التوقف قليلاً مع شؤون الأردن وشجونه" من منطلق "صيانة مكاسبه وإسداء التحية إليه مع الحب النبيل المرتبط بحرية التفكير وحرية التعبير"..
ثم تأتي مصر الكنانة التي "تستغرق من يزورها إيجابيات لا تعد" ولكن هذا لا يمنع من التصريح بأنها وهي "المكتنزة بطاقات وإمكانيات عالية عملاقة بحاجة لشراكة جميع أبنائها، بقدر ما هي بحاجة لتحديث شامل يتجاوز الماضي المحنط"..
وهكذا يمتد الهم من السودان إلى العراق، ومن الشام إلى الجزائر، حتى لا تكاد تجد بلداً عربياًُ يغيب عن ذهن المؤلف وخاطره، بأسلوب مهذب هو أشبه بالعتاب مع الأحباب، أسلوب محمل بهمّ جمع الصف ونبذ الخلاف ما أمكن يتمنى المرء لو يسود في خطاب المثقفين في معرض نقد السلبيات والحديث عن الأخطاء..
ولما كان المؤلف (شامياً) يحمل بين جوانحه روح الشعراء، فإن شوقه إلى الشام وحنينه إلى ربوعها يتجلى في كلمات تشبه الشعر المنثور.. فهي بالنسبة إليه "وحدها معالم خريطتي ومشارف حدودي، ترتوي من نضارتها قامتي وعيناي، فعيونها دوماً منهل عذب لمن يهوى الهوى، يصبه صافياً بين يدي ليلاه!".. ولكن كل هذا الهوى وكل تلك الصبابة لا تمنعانه من العودة إلى الربط بين همه الأصلي وبين مرتع صباه وملعب شبابه، فتراه يقول "إن الحب لا يكفي لتبرير التناقضات أو المستحيل، فما نحتاجه للشام وهي تشدنا إلى عتبة البقاء، أن نعي دروس التاريخ دون أن ننسى طبيعة العصر وأن نؤمن بحتمية التطور وقداسة العمل".. وبخلاف كثير من المثقفين السوريين، إسلاميين وغير إسلاميين، نجد المؤلف يمارس العدل في توزيع المسؤولية على مختلف الأطراف التي تساهم في رسم مصير بلاده ومستقبلها، من هنا يؤكد قائلاً: "وكما نطالب السلطة باستحقاقات التغيير واستقراء الملاحظات فإن تحمّل مسؤولية المرحلة وموجباتها، يتطلب كذلك من التجمعات السياسية المؤيدة والمعارضة أن تبدأ بإجراء مراجعات هادئة وجدية وتقويمية لمختلف برامجها ومشاريعها، كمدخل لإرساء التعاون مع الآخر، بدلاً من تجاهل الوضع والواقع، والتمترس وراء التردد أو الشمولية".
ومن هموم الأستاذ عبد الله الواضحة في الكتاب تأكيد معاني الانفتاح على الآخر أياً كان ذلك الآخر، وإشاعة قيم الحوار بالتي هي أحسن. ومن خلال هذه المعاني والقيم يتحدث عن الحوار القومي الإسلامي وعن الغرب وعن الأنظمة وعن الحركات والأحزاب، بلهجة المشفق المحبّ، وبلغة بعيدة عن التشنج والعصبية والأحكام القاطعة والمواقف المسبقة التي أصبحت ملازمة لقطاع واسع من الخطاب العربي على تنوع خلفياته الأيديولوجية..
أما الهم الأكبر الذي يبدو وكأن جميع الهموم الأخرى تتمحور حوله فإنه يتمثل في إصلاح قاعدة الفكر الإسلامي والعربي المعاصر، وبالتحديد في استعادة المدخل التجديدي المقاصدي عند فهم الإسلام وعند محاولة تنزيله على الواقع.. فالمؤلف ينعى في أكثر من موضع على أولئك الذين لا يزالون مصرين على الحياة في هذا العصر بدرجة من "البدائية الفكرية".. وهي بدائية تحمل كثيراً من السلبيات، ففي حين يحارب هؤلاء الحرية يذكرهم المؤلف بحقيقة تقول بأنه "انتهت دعوات فتح نوافذ الحرية فقد فتحت عنوة".. وعندما يصرون على الحركة والعمل بمنطق الأبطال الذين يتقنون كل فن ويحسنون كل علم، ينبههم بأنه "بات من العسير جداً أن يُقبل بمنطق الواحد لكل الأحداث، أو الشخص الواحد لكل الاختصاصات".. وعندما ينتقصون من قيمة العلم والمنهجية مركزين على نوع واحد من أنواع العلم هو العلم الشرعي، فإنه يطلق في وجوههم صرخة تؤكد على أن "من يطمح لمكان تحت الشمس في الألفية المقبلة هو من يدرك أهمية التطور العلمي والتقني مع استقامة الفكر والسلوك، وليس من يعبد الله ليستأكل به الناس!!".. وعندما يمارس هؤلاء عمليات التزييف وخلط الأوراق يقوم المؤلف بفضح هذه الممارسات، ضارباً المثال بما جرى في أيام أزمة العراق، فبدلاً من "انشغال المفكرين بمهام التوعية والتنوير، وإشاعة السننية والسببية ذهبوا إلى ردود الأفعال، وثقافة التوريط والهروب للأمام، ويزداد المدار بؤساً بالإصرار على تأصيل القصابين والظلمة، أبطالاً ورموزاً للحرية الشهيدة".
ورغم إدراك وجود هذه السلبيات، وبعكس الكثير من كتّاب ومثقفي هذا الزمان الذين يغلب عليهم التشاؤم واليأس، تشعّ من كلمات الكاتب روح التفاؤل والأمل والنظر إلى المستقبل. بل إنّ همَّ المستقبل بالذات يبدو واضحاً بشكل مباشر وغير مباشر من خلال أكثر من مقال وأكثر من عنوان، والحقيقة أن الانشغال المبالغ فيه بالماضي أو الغرق الكامل في الحاضر، وافتقاد القدرة على استشراف آفاق المستقبل، وهو ما يمكن القول بأنه صفة كثير من المثقفين يمثل آفة كبرى من آفات ساحتنا الثقافية، وهي آفة تدلّ أولاً وقبل كل شيء على عدم امتلاك الأدوات العقلية والفكرية التي تنبثق منها الفاعلية النفسية والعملية الضروريتان لأي عملية تغيير وتطور، ذلك أن بإمكان الكثيرين نقد الماضي أو توصيف الحاضر، ولكن القلائل هم الذين يمتلكون ذلك الزاد الثقافي المشبع بالحيوية الذي يمكنهم من الانشغال بالمستقبل، من حيث تحديد ملامحه، ورؤية واستنباط البرامج والوسائل والأساليب التي تؤدي إلى صناعته بإرادة وعن سابق تصميم وإصرار..
واستمراراً لأمانته مع منهجه الفكري، يلامس المؤلف بعض المناطق الحساسة في ثقافتنا العربية الإسلامية بصدق وشفافية، دونما مواربة وبعيداً عن ذلك الأسلوب الذي يستخدمه البعض حين يجعلون كلامهم حمّال أوجه في المناطق الحساسة، ليضمنوا بذلك خط رجعة إذا ما واجههم بعض التقليديين ويظهر هذا واضحاً على سبيل المثال عند مقارنة المؤلف لواقع المرأة العربية والمسلمة، فهو على المستوى العام مثلاً ينعى على "الثقافة الذكورية" ويعلن على الملأ حقيقة "إهمال الرجل للتراث النسوي على مدى التاريخ الإسلامي، برغم وجود آلاف الأسماء في كل علم من الدين والدنيا" ويؤكد أن ما جرى بذلك الخصوص هو "ظلم وظلام أرجعا الأمة القهقرى تحت لافتة سد الذرائع والخوف من الفتنة".. أما على مستوى الحركات والجماعات الإسلامية وموقفها من دور المرأة وقيمة عطائها فإنه لا يتردد في التصريح بأن "الدعوة الإسلامية لا تزال عرجاء تمشي على قدم واحدة حتى تتحمل المرأة المسلمة مسؤوليتها، لن يحدث ذلك ما لم نبادر للعمل على ترميم واقعنا".. ثم إن مؤلفنا يتجاوز التعميم والتجريد ليعطي قرّاءه، في مقال آخر، نموذجاً على موقفه الشخصي من المرأة حين نراه يحتفي بامرأة عربية مسلمة مثل توجان فيصل التي يصفها بأنها "أنثى عصيّة تصر على تدجين زيف العالم وترفض أن تكون فراشة ملونة".. ليضيف بعد قليل قائلاً "توجان فيصل تعبير عن التيار والمتغيرات، فيها من حزم زنوبيا ومناورة شجرة الدر واعتداد تاتشر وجمال مارلين مونرو.. قد أُعلن اختلافي معها قليلاً أو كثيراً، ولكن أُثني على أريحيتها وحيويتها".. والذي يعرف مواقف الإسلاميين التقليدية من المرأة وطريقة ومقاييس حكمهم عليها من جهة، ويعرف من هي توجان فيصل من جهة ثانية، يعرف ولا شك أن موقف الأستاذ عبد الله هو أبعد ما يكون عن الموقف الإسلامي التقليدي من المرأة، ويعرف أن هذا الموقف العملي إنما هو في الحقيقة منهج ذكي يحمل دلالات وإشارات تتجاوز دلالات الكلام المباشر في كثير من الأحيان..
وهكذا، يمضي مؤلف الكتاب بنفس الطريقة وبنفس المنهج، وينطلق من نفس المبادئ والمقدمات التي تؤمن بها، ليعالج جملةً من القضايا الأخرى التي تجمعها دفتا هذا الكتاب، لتكون هذه الأمانة للمنهج وللمنطلقات علامة أخرى مميزة تضاف إلى العلامة الأولى التي تتمثل في ملامسته اللصيقة بهموم عصره وزمانه.
وإذا كان من ملاحظة يقتضيها المقام فإنها تتعلق بضرورة تحرير المعنى المقصود ببعض الجمل والعبارات الحساسة، من مثل العبارة التي ترد في نهاية الحديث عن "الفقه الحضاري: ويقول فيها المؤلف بأنه "لا توجد أي حضارة بوذية أو كونفوشية أو يهودية أو مسيحية" ذلك أن إطلاق مثل هذا الحكم يستوجب نوعاً من التحديد لمعنى الحضارة وماهيتها، وللقيم الحقيقية التي تنبني عليها مضار معينة، وما إذا كانت هناك حقاً حضارات تتمحور بشكل جذري وعميق حول قيم البوذية أو المسيحية على سبيل المثال أم لا.. ورغم أننا ندرك أن الكتابة الصحفية السريعة لا تحتمل في كثير من الأحيان الاستفاضة في شرح مدلولات المصطلحات والتعابير كما هو الحال مع البحوث العلمية المطولة، غير أن حرص المؤلف الكريم الواضح على قيمة الدقة العلمية هو الذي يدفعنا لطرح هذه الملاحظة، ويكفي مثالاً للدلالة على هذا الحرص ذلك الهامش الصغير الذي وضعه المؤلف عندما استدل في أحد مواضيع الكتاب بما يسمى بروتوكولات حكماء صهيون، ثم إنه أشار في الهامش المذكور إلى أن الدكتور عبد الوهاب المسيري يشكك في وجود مثل هذا الكتاب ابتداءً وهي ممارسة راقية تحترم الأمانة العلمية من جانب، وتحترم عقل القارئ من جانب آخر، لأنها تقدم له الرأي والمعلومة ثم تترك له حرية التحليل والاستنتاج.
وختاماً، فإن أحد أهم معايير الحكم على إنتاج فكري معين يتمثل في مدى قدرة المنتج على تحقيق الأهداف الكامنة وراء العطاء الذي يقدمه، وقد أراد كاتب هذا الكتاب أن تكون مواضيعه إسهاماً في "تجديد ذوقنا الفكري" وأن تعبر عن تمرد على "موت الكتابة" وقبل ذلك وكله، كانت رغبته الأساسية تتمحور حول تمرين العقل العربي والمسلم على التعامل مع أفكار لا تحدّها الأسوار، وحسبه نجاحاً أن القارئ سيقرأ هذه الصفحات ليجد فيها توليفة ذات نكهة خاصة من الجديد المفعم بروح من التمرد، وإن كانت هادئة هدوء شخصية المؤلف غير أنها على وجه اليقين طليقة من القيود وحرة تسبح في فضاءات الفكر والثقافة بعيداً عن حصار الأسوار.
![]()
![]()
![]()
* أسهم في تأسيس مركز دراسات الثقافة والحضارة في الولايات المتحدة، وهو مركز يهتم بدراسة شروط ووسائل امتلاك المنهجية لدى العقل العربي والمسلم، وخاصة عن طريق العلوم الاجتماعية والإنسانية، أطلق مجلة (الرشاد) وكان أمين تحريرها لعدة سنوات، وطرح فيها ضرورة وجود (الخطاب الوسيط) الذي يصل ما انقطع بين فكر الخاصة وحركة العامة.
كان مستشاراً لعدة
مؤسسات عربية وإسلامية عاملة في الولايات المتحدة، ومديراً لمركز مناهج اللغة
العربية والتربية الإسلامية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ينشط حالياً في مجالات
الإعلام والفكر والتدريس الجامعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.